الربيع العربي وإشكالية الدولة والديمقراطية: حديث في الدولة المدنية.. اليمن ومصر أنموذجاً
السياسية - Tuesday 02 March 2021 الساعة 07:54 am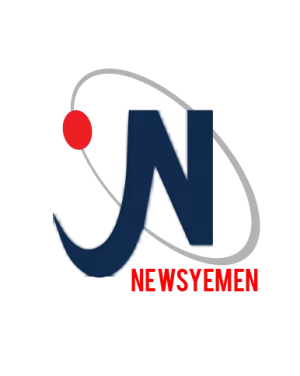 نيوزيمن، كتب/ فهمي محمد:
نيوزيمن، كتب/ فهمي محمد:
بغض النظر عن المآلات التي انزلقت إليها جُل ثورات الربيع العربي إلا أن ثنائية الدولة المدنية بمفهومها الواسع = (الدولة المؤسسية والنظام الديمقراطي)، كانت هي المطلب الثوري الذي تحركت خلفه الجماهير العربية الثائرة؛ ومع أن في حقيقة تطبيق مثل هذا المطلب الثوري؛ يكمن الحل الجذري للمشكلة العربية ذات الجذور التاريخية = (الاستبداد السياسي وثقافته) على اعتبار أن حل المشكلة السياسية هو المدخل الطبيعي المؤدي للحلول الشاملة، إلا أن واقعنا السياسي بعد ثورات الربيع العربي أفرز أسئلة جوهرية ذات خصوصية عربية، تتعلق بإشكالية الدولة والديمقراطية “لا سيما” في حال نجاح الفعل الثوري في إزاحة القوى الممانعة عن المشهد السياسي أو التحكم في مخرجاته وأنساقه، حتى وإن كان هذا النجاح مؤقتًا يفتقد لشروط الأمان والسلامة في معركة التغيير الثورية المتجهة نحو المستقبل، أو كان مجرد تنازل تكتيكي من قِبل القوى الممانعة تاريخيًا لمفهوم الدولة الضامنة والديمقراطية السياسية والتعددية، كما حدث في اليمن ومصر الدولتين اللتين شهدتا “انقلاباً” على المسار الثوري بعد أن تم إحراز تقدم يذكر ويعتد به في فعل التحول والتغيير، وفي المقابل فإن فعل التغيير الثوري في هاتين الدولتين يعد من جانب آخر “نموذجاً سياسيًا عملياً يتعلق بصُلب أسئلتنا الإشكالية المتعلقة بالدولة والديمقراطية” = (ثنائية الدولة المدنية).
ما نقصده هنا بتلك الإشكالية، أو بسؤالنا الإشكالي يتعلق بوجود مسألة الدولة الوطنية والديمقراطية السياسية =(دولة مدنية)؛ هل يجب أن تبدأ في واقعنا من نقطة التوافق الوطني أم من نقطة التنافس الانتخابي لا سيما فيما نحن عليه اليوم في الواقع العربي؟
وأياً من هذه الثنائية المتلازمة سياسياً في مفهوم الدولة المدنية تشكل سابقة وجودية وحالة ناظمة للأخرى الدولة كفكرة سياسية وطنية بمفهومها العضوي والمؤسسي القانوني والدستوري المعبر عن إرادة شعب أو أمة = (عقد اجتماعي) أم الديمقراطية بمفهومها كنظام سياسي تعددي يعطي الحق للأغلبية العددية من الشعب في ممارسة السلطة والحكم عن طريق صناديق الإقتراع السري = (آلية تتعلق بشرعية وصول الحاكم إلى رأس السلطة وإدارة سلطة الدولة)؟
إن مبعث مثل هذه الأسئلة المركبة يعود في الأصل إلى حقيقة وجود حالة من الخصوصية السياسية والتاريخية والثقافية وحتى الاقتصادية التي تستوجب على الفعل الثوري التعاطي معها بمنطق إحراق المراحل التاريخية “لا سيما” في زمن الربيع العربي بعكس ما حدث في التجربة الأوروبية، بمعنى آخر ما حدث في التجربة الأوروبية كان تطورا مرحليا تاريخيا جذريا يعبر عن وجود صيرورة من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية وحتى النضالية التى ارتبطت بشكل أساسي بنجاعة الدور الفاعل للمثقف الإنتلجنسي الذي سخر قدراته المعرفية وفكره الناقد ومنهجه العقلاني في سبيل مطاردة الحقيقة، ثم حول هذه الحقيقة بعقل مفتوح إلى أفكار أو مشاريع ثورية تسلح بها فعل التغيير المرحلي؛ وحتى بمنطق سياسي ثقافي يتجاوز مفهوم التحزب السياسي والفئوي والمناطقي وكل المشاريع الصغيرة والنخب السياسية التقليدية، أي بمنطق قادر على استقطاب الجماهير بناءً على قيم وأفكار ذات أبعاد وطنية ومدنية خالصة، كما أن التغيير المرحلي هنا لا يقصد به حدوث ترحيل للحلول السياسية في التجربة الأوروبية أو القبول ببعضها أو حتى تنصيفها في وجه المشكلة السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية التي كانت قائمة، بقدر ما يعني هنا أن فعل التغيير كان قادرا على الحضور الواعي والعقلاني في كل المراحل التاريخية، التي تطورت خلالها مفاهيم الدولة المدنية حتى استقرت هذه المفاهيم الحضارية والمدنية في الحاضر السياسي لهذه الشعوب المتمدنة على هذه الثنائية المتلازمة “سياسياً” بين مفهوم الدولة المؤسسية القانونية والديمقراطية الليبرالية.
سؤال الدولة المدنية الذي تعنونت به الثورات العربية كمطلب واجب التنفيذ وحال الأداء في زمن الربيع العربي لم يُطرح على طاولة النضال الوطني دفعة واحدة كمطلب ثوري حال الأداء في التجربة الأوروبية؛ بل كان نتيجة للعديد من التحولات التاريخية التي قادها فعل التغيير الثوري في معادلة “صراعِه” المرحلي مع القوى التقليدية الممانعة لفكرة الحرية “بدءًا” من الصراع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية والذي انتهى بانتصار هذه الأخيرة التي تحولت فيما بعد إلى سلطة عائلية مستبدة أو ملكية مطلقة أو في أحسن أحوالها سلطة زمنية قائمة على الامتياز الشخصي لمكونات أسرية بذاتها، وهي التي مارست فعل الاحتكار للمجال السياسي العام؛ لتبدأ على إثر هذا الانتقال جولة من الصراع والحراك الثوري “لا سيما” بعد أن ضاق المجتمع في أوروبا “ذرعاً” بمغامرات الحكام وسوء استخدامهم لهذه السلطة العامة التي بدأت وكأنها تخضع لمفهوم الحيازة الشخصية وتمارس سلطة الامتياز الشخصي، وقد انتهى هذا الصراع الذي قاده فعل التغيير الواعي بتحويل هذه السلطة القائمة على البعد الشخصي الأسري إلى مؤسسة قائمة على البعد القانوني والدستوري = (دولة المؤسسات والقانون).
بمعنى أدق تحولت السلطة إلى دولة بالمفهوم الحديث مع ظهور وتطبيق المفهوم المؤسسي والقانوني الذي تكفل جذرياً بحل المشكلة التاريخية المتعلقة بالسلطة عن طريق تحرير هذه الأخيرة من سلطة الأفراد والجماعات وحتى العائلات وتسليمها إلى سلطة القانون والدستور = (سلطة الفكرة) (*).
بهذا التحول التاريخي والثوري الذي أدى إلى اختراع فكرة الدولة تحول الفرد إلى مواطن لا سيما أن المواطن مع هذا التحول السياسي بدأ يشعر أنه لا يطيع أشخاصا بذواتهم أو حتى يخضع لنفوذهم الشخصي، بل أصبح يقاد بفكرة الدولة المناط بها تطبيق القانون والدستور اللذين أصبحا في ظل هذا الشكل السياسي والاجتماعي الجديد سلطة عليا فوق الحاكم والمحكوم، هذا يعني أن السلطة في ظل الدولة تحولت إلى وظيفة عامة والحاكم تحول إلى موظف عام في جهاز الدولة محكوم هو الآخر بسلطة الدستور والنظام والقانون؛ بحيث أصبحت منظومة القانون تحدد ما للحاكم وما عليه؛ بل وتجيز محاكمته ومحاسبته وعزله أمام مؤسسات الدولة في حال إن أساء استخدام سلطة الدولة بأي شكل من الأشكال.
صحيح أن الحاكم في ظل الدولة ما زال يمارس سلطة عليا تجاه أفراد الشعب، كما أنه فوق ذلك أصبح “رمزاً”ً سيادياً لفكرة الدولة، وهذا ما يجعل منه شخصاً محاطاً بـ(هيلمان السلطة) وبريقها الأخاذ؛ لكنه في المقابل يظل “محكوماً” وخاضعاً في كل ممارساته لدستور الدولة ومؤسساتها التى اخترعها الشعب وتعبر عن إرادته في نفس الوقت؛ بمعنى آخر أصبح الرئيس في الدولة منفذا لسلطة القانون والدستور لا حاكمًا بمفهوم السلطة المطلقة، لهذا نجده وفق أدبيات الدولة يُعَرَفْ بكونه (رئيس السلطة التنفيذية) يقابله في هذه الأدبيات رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية، هذا يعني أن الدستور هو الذي يوزع الصلاحيات ودرجة التراتبيات وحتى المزايا لهؤلاء الرؤساء في جهاز الدولة على اعتبار مواقعهم الوظيفية والسيادية وليس على الاعتبار الشخصي أو الانتماء الاجتماعي.
عند هذا الحد من التحول السياسي الذي قادهُ فعل التغيير الواعي في التجربة الأوروبية؛ وُجدت الدولة المؤسسية التي أخذت “بعداً قوميًا” ثم تموضعت مؤخراً على البعد الوطني بصيرورتها النهائية؛ لكن بعض التجارب الثورية لم تقف عند هذا الحد من التطور السياسي ولم تكتفِ بظاهرة الدولة المؤسسية أو دولة القانون أو الدولة الوطنية، لا سيما فيما عرف تاريخياً بدول الغرب الرأسمالي، وذلك يعود لوجود سببين جوهريين، هما:
- الأول:
إن دولة المؤسسات أو دولة القانون بمفهومها العضوي الكلاسيكي لم تستطع أن تحدث قطيعة تاريخية بشكل مطلق ونهائي مع مفهوم الاستبداد السياسي الذي ظل وجوده ممتداً، بل يشكل أسباباً لاستمرار حالة الاحتقان السياسي “لا سيما” فيما يتعلق بطريقة وصول الحاكم إلى رأس سلطة الدولة واتخاذ القرارات السياسية فيها، وكذلك فيما يتعلق بممارسة الحقوق والحريات داخل الجماعة المحكومة؛ صحيح أن الدولة بالمفهوم السابق هي دولة قانون ودستور وقد حقق بعضها كثيراً من التحولات والتقدمات على كل المستويات والأصعدة بما في ذلك تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية؛ لكنها ظلت في أحسن أحوالها دولة المستبد العادل.
هذا يعني أن كعب الدولة الأخيل (في أحسن صورها) تمثل في إصرارها الممانع على عدم فتح باب المشاركة السياسية بأدوات ديمقراطية أمام المكونات الاجتماعية والسياسية والتى أفرزها الواقع المتحول، وهو ما أدى إلى اتخاذ منهج العنف أو الانقلابات العسكرية “طريقاً” وسبيلًا للوصول إلى سلطة الدولة، وهذا ما يفسر ظاهرة التعاقب للحكام العسكريين أو ظاهرة حكم الحزب الواحد والقائد في هذه الدول؛ “لا سيما” في زمن الأيديولوجيات التي غزت أوروبا الشرقية وحلفاءها في أرجاء المعمورة.
عندما يكون العنف هو طريق الوصول إلى كرسي الرئاسة، فإن الحاكم بمجرد وصوله إلى كرسي الرئاسة (فرداً كان أو حزباً) سوف يسعى جاهداً نحو امتلاك كل أدوات القوة والسيطرة وكذلك احتكار وسائل التأثير والنفوذ على المستوى السياسي والاجتماعي حتى يضمن البقاء على رأس السلطة مستغلاً ظاهرة السكونية السياسية الاجتماعية في الشعوب الخاملة، وهذا ما أدى إلى عودة قوية لمفهوم السلطة بشكل جعل من هذه الأخيرة “قادرة” على ابتلاع مفهوم الدولة ومؤسساتها وحتى مفهوم الوطنية السياسية على اعتبار أن الوطنية هي مجرد قيم ومبادئ وأهداف وجدانية سامية وإنسانية؛ لكنها “حتماً”ً تموت في ظل وجود ظاهرة الاغتراب السياسي أو في ظل وجود مجال سياسي عام مغلق و”أحادي التكوين” إلا في حضرة الزعيم الملهم أو في حضرة الحزب القائد والمسيطر.
- الثاني:
إن تلك التحولات الثورية التي أنتجت الدولة بمفهومها المتجاوز لمفهوم السلطة ارتبطت في أوروبا منذ البداية بوجود سلطة أهل الفكر (فلاسفة ومنظّرين ومفكرين وكتاب ومثقفين وغيرهم…)؛ أي أن تلك التحولات كانت متسلحة ابتداءً بعين بصيرة وثاقبة في مسار التغيير، وهذه السلطة الخالية من الأدوات المادية ساهمت في كثير من التحولات ليس على المستوى السياسي فحسب؛ بل على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي؛ فعلى المستوى السياسي وانطلاقاً من واقع الحال القائم والمتغير في أوروبا؛ تم تأليف أعظم الكتب المتعلقة بالفكر السياسي وكذلك المتعلقة بعلم الاجتماع والسياسة والفلسفة على يد أعظم الفلاسفة والمفكرين على الإطلاق؛ كذلك على المستوى الثقافي تم تحويل قيمة الحرية والتسامح والقبول بالآخر وثقافة الحوار إلى نظام معرفي ثقافي في تلك الشعوب أو قل إلى جهاز مفاهيمي حداثي يمارس حالة من التحكمية، بل ينفخ الروح في الثقافة وفي سلوك العامة داخل الوسط الاجتماعي (عقل سائد أو عقل جمعي متمدن) وحتى على المستوى الاقتصادي تغير نمط الإنتاج بشكل كبير وشهد الفكر الاقتصادي أعظم التحولات والجدل العلمي مع بروز أعظم نظرية علمية إنسانية في عالم الاقتصاد (الماركسية) التي خاضت جدلاً وصراعاً إنسانياً مع نظيرتها الرأسمالية.
كل ذلك انعكس “إيجابيًا” على المستوى الاجتماعي، حيث شهد المجتمع تغيرا كبيرا في بنية نظامه التراتبي، وفي قِيمه الثقافية وحتى في شكل المؤسسات الناظمة والتي كانت تمارس دوراً تحكمياً في حركة الجماعة وفي العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات “لا سيما” المؤسسات التقليدية العصبوية “قبلية أو دينية مذهبية…” التي فقدت وظيفتها التاريخية في تلك الظروف لصالح مؤسسات حديثة مدنية نشأت على إثر هذه التحولات السياسية والثقافية وحتى الاقتصادية التي طالت قاع المجتمع ومسّت كل مكوناته، ولم تتوقف على سطحه القشوري كما هو حال البُلدان العربية التي عاشت عقودا وما زالت حتى اليوم تعيش في وهم الدولة الوطنية التي تبخر بعضها وتلاشى بشكل يتجاوز مفهوم السقوط على إثر سقوط الحاكم العربي بفعل ثورة الربيع!!!.
كل هذه التحولات الجذرية والإرهاصات ذات الأبعاد المتعددة التي قادها فعل التغيير المرحلي بوعي سياسي أدت في مجملها إلى قطيعة تاريخية عميقة وليست قشورية مع كل ما هو تقليدي وممانع لمفهوم التقدم والتطور والتمدن والتعدد، وأكثر من ذلك قطيعة مع كل ما هو متعارض مع العلم والعقل ومبادئ الإنسانية، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بصلب حديثنا، فقد شهد المجتمع الأوروبي على المستوى الأفقي “نشوء” المذاهب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب السياسية، التي قدمت نفسها كـ أدوات مدنية ووطنية تمارس الفعل السياسي بمفهومه المدني بناءً على مشاريع وبرامج سياسية قادرة على استقطاب الجماهير وتوظيفها في عملية التدافع السياسي الذي ساهم إلى حدٍ كبير في بلورة مفهوم التعددية السياسية وفتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة كبيرة تتعلق بشرعية الوصول إلى كرسي السلطة وكذلك بمفهوم المشاركة السياسية “لا سيما” في إدارة السلطة والثروة والقرار السياسي في الدولة الوطنية.
وحتى لا تتحول السياسة أو فعل التدافع السياسي في هكذا واقع متحول ومتغير إلى حالة من الاحتقان في ظل عدم التعاطي الإيجابي مع هكذا أسئلة، فقد تم اللجوء إلى إحياء فكرة الديمقراطية بكل أبعادها الحديثة وتحويلها إلى نظام حكم وآلية سياسية تضاف إلى دولة المؤسسات والقانون بعد أن اكتملت شروط هذه الأخيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والوطني، بمعنى آخر أن الديمقراطية وفق آلياتها السياسية العملية والمدنية أصبحت قادرة على امتصاص حالة الاحتقان السياسي داخل الوسط الاجتماعي وداخل أجهزة الدولة وقنواتها السياسية، بل وتمكنت من إزالة أسباب هذا الاحتقان بشكلٍ جذري.
فالديمقراطية بناءً على هذا المنطق أسست أولاً: ــ مجالاً سياسياً عاماً مفتوحاً أمام المكونات السياسية والاجتماعية، أي مجال سياسي عام يقوم على مفهوم التعدد والتنافس السلمي الديمقراطي، بعد أن كان مجالاً سياسياً محتكراً ومغلقاً، وهي ثانياً: – حددت آلية عملية تنافسية تتعلق بطريقة الوصول إلى كرسي السلطة تعتمد على (عد الرؤوس وليس على قطعها) على حد وصف الباحث على خليفة الكواري في معرض حديثه عن مفهوم الديمقراطية المعاصرة، هذه الآلية العملية هي التي جعلت الديمقراطية قادرة على تجاوز فكرة الشورى التي ما زالت حتى اليوم فكرة نظرية عائمة غير قادرة على تقديم النموذج العملي الناجع، ناهيك عن عجزها في الماضي عن التحول إلى نظام سياسي قائم كما هو حال الديمقراطية في التجربة الأوروبية التي جعلت المواطن في ظلها يشعر على الدوام بفكرة الاقتدار السياسي بدلاً من شعوره بحالة الاغتراب داخل بلده وموطنه كما هو حال المواطن في جميع الأقطار العربية.
على إثر هذه التحولات الثورية التراكمية والنوعية “لا سيما” فيما يتعلق بفكرة الحرية السياسية داخل التجربة الأوروبية؛ وجد المواطن نفسه أمام دولة مدنية مكتملة الأركان والشروط على المستوى الفوقي يحايثها في الواقع الاجتماعي على المستوى التحتي حامل موضوعي يتمثل بوجود نظام ثقافي تعددي عام وسائد في المجتمع يتخلق واقعياً ومرحلياً بفعل التجذير والتأصيل للقيم المدينة والإنسانية والأخلاقية للحد الذي تحول في ظلها هذا النظام الثقافي العام إلى عقل جمعي أو جهاز مفاهيمي طارد للقيم الماضوية وثقافتها لا سيما ثقافة الاستبداد والعنف والاقتتال ومنهج الإقصاء، وأكثر من ذلك أصبح هذا العقل الجمعي المدني حاضراً على الدوام ومؤثراً في العملية السياسية وغير قابل للمساومة أو التنازل أو حتى المساكنة السياسية الاجتماعية حين يتعلق الأمر بمسألة الحقوق والحريات، وهذا يعود كما قلنا بشكل أساسي وجوهري للدور الذي لعبته سلطة أهل الفكر التي ما زال واقعنا العربي يفتقد لحضورها الفاعل والمؤثر والمحايث لفعل التغيير السياسي وعلى وجه التحديد في زمن الربيع العربي.
فالمثَقَف أو المفكر العربي ما زال حتى اليوم يمارس دوره المتفرد كمتكلم وكاتب داخل هذا القطر العربي أو ذاك ولم يتحول وجوده المتعدد والمتفرد إلى عمل جمعي تقوده نخبة انتلجنسية متماسكة أو حتى عضوية متجانسة تشتغل على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتعمل على مطاردة الحقيقة دون هوادة أو تملق، بل وتمارس فعل التغيير بعقل مفتوح وفاعل، وبشكل يؤدي فعلياً إلى تأسيس سلطة أهل الفكر كسلطة حاضرة ومؤثرة في معادلة الصراع السياسي، بمعنى آخر المثقف العربي أو المفكر العربي برغم عطائه النظري ما زال حتى اليوم هو أشد الكائنات التي تعيش حالة من الاغتراب أو العزلة السياسية لحد التقوقع داخل محيطه الاجتماعي والسياسي.
إحدى المعضلات في معركة التغيير العربية تتمثل بوجود فجوة كبيرة بين عطاء المثقف العربي ودوره التنويري، وقابلية المجتمع العربي وحاجته لفكرة التغيير، على اعتبار أن أسباب الثورة تظل قائمة ومستمرة، وهذه المعضلة ساهمت بشكل كبير بوجود حقيقة تقول إن فعل الربيع العربي الذي اعتمد أساساً على حركة الجماهير الثائرة، تحرك يومها دون نظرية ثورية أو فلسفة ثورية أو حتى مشروع ثوري متكامل يؤطر حركة الجماهير في فلكه منذ البدء، أو أن فعل التغيير تحرك كـ (فرس مقطوع الرأس) على حد وصف الصحفي الكبير “غسان بن جدو”، وللقارئ هنا أن يضع خطاً أحمرَ تحت عبارة ”مقطوع الرأس” ويقرأ ما يشاء من الدلالات وحتى المآلات المرتبطة بها = (شكل مخيف، عدم القدرة على رؤية الطريق والقاع الذي سوف تصل إليه النهايات، وعدم القدرة على التعاطي مع الأحداث التي تواجه الثورة في معركة التغيير، وعدم القدرة على استقطاب كل الشرائح والمكونات وحتى القوى الصامتة)، لأن رأس الثورة وتقاسيم وجهها الذي يحدد هويتها السياسية والاجتماعية، وحتى المستقبل بالنسبة لكل هؤلاء المطلوب منهم الانضمام إلى ركب الثورة في زمن الربيع العربي كان غير موجود أو غير محدد الملامح بشكل كافٍ، أو أنه مقطوع، على حد وصف صاحبنا الذي لا نوافقه الرأي في كل ما يذهب إليه من نقد لثورة الربيع العربي، فالثورة كفكرة –بلا شك– كانت وستظل هي المخرج للواقع العربي ولا غبار على ذلك من حيث المبدأ، لكن فعلها الثوري يظل قابلاً للنقد والتصويب والتقييم، وكذلك الحال ينطبق على الحكام في سلطة الثورة وعلى وجه الخصوص في اليمن، فهؤلاء أسوأ نموذج أفرزه فعل التغيير الثوري في هذا البلد، إذ لم يكونوا هم مسبة الفكرة الثورية وعيبها الأسود أو أنهم خطيئة الفعل الثوري على الإطلاق لا سيما حين يراد من هذا الفعل تأسيس الدولة المدنية بمظهرها أو شكلها الاتحادي في اليمن…!!
بيت القصيد في هكذا سردية مكثفة تناولت في مجملها أبعاد تلك التطورات التاريخية والمرحلية في صيرورة الدولة المدنية داخل التجربة الأوروبية تعني أولاً:
أن الدولة المدنية لم تكن سؤالاً إشكالياً أو مطلباً ثورياً حال الأداء أمام الفعل الثوري كما هو الحال بالنسبة لنا في جميع الأقطار العربية، بل كانت، أي الدولة المدنية، نتيجة طبيعية لتلك التحولات والتطورات الثورية التي اتخذت مسارات متعددة ولكنها متحايثة على المستوى الرأسي وعلى المستوى الأفقي وحتى على المستوى التحتي التي لم تكتفِ بإخفاء التجاعيد الموجودة على سطح المجتمع كما هو حال تجربتنا العربية، بل غاصت تلك التحولات الجذرية بفعل التغيير الثوري داخل أعماق المجتمع الأوروبي حتى قاعه الأخير وبشكل أدى إلى قطيعة فعلية مع كل ما هو ماضوي وممانع لمسار التقدم والتطور نحو المستقبل.
أما ثانياً: فقد كانت هذه السردية المكثفة ضرورية في هذه الدراسة لكونها قادرة على تقديم صورة متكاملة عن تلك المعطيات والرافعات التي شكلت بمجملها حاملات موضوعية للدولة المدنية وحتى لاستمرارها كحالة سياسية ناجعة في المجتمع الغربي = (الشروط الموضوعية).
ما يجب أن نفهمه هنا أن فعل التغيير في التجربة الأوروبية لم ينجح في تغيير ما هو قائم أوحتى في هدم ما هو قائم ومرفوض، بل نجح فيما هو غائي من وراء هذا الفعل الثوري والذي تمثل في إنتاج شروط التحول التاريخي أو قل نجح فعل التغيير الثوري في خلق القابلية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الملائمة لتطبيق المشروع الثوري = (الدولة المدنية الحديثة)، وذلك في اعتقادي مربط الفرس في أي عملية ثورية تتوخى التغيير الجذري في أي مجتمع، إذا لم يكن ذلك هو المبرر السياسي والأخلاقي للفعل الثوري وحتى لتلك التضحيات التي ترافق العملية الثورية في كل زمان وفي كل مكان، بمنطق آخر يظل مقدار النجاح في إنتاج شروط التحولات الثورية التي تمس حياة الأفراد والجماعات بشكل إيجابي هو الفارق الجوهري الذي يجعل من الثورة حدثاً سياسياً أو حدثاً تاريخياً في الذاكرة الوطنية وحتى في التاريخ السياسي حين يكون هذا الأخير قادراً على تدوين الأحداث الثورية في تجارب الشعوب، وذلك على اعتبار أن الفعل الثوري في بعض التجارب الثورية قد ينجح في مسألة الهدم وحتى في تغيير الوجوه ولكنه يكرر الفشل بشكل دائم في تغيير التوجه كما هو الحال بالنسبة للأقطار العربية عموماً واليمن على وجه الخصوص.
الحديث عن مسألة الفشل المتكرر في تغيير التوجه أو ”تكرار الرسوب في اختبارات السياسة” على حد وصف الأنصاري في كتابه "العرب والسياسة أين الخلل"، هو الذي يقودنا للحديث عن إشكالية الدولة والديمقراطية في زمن الربيع العربي، كما أن مجرد التفكير بعقل مفتوح في مسألة تجاوز هذه المعضلة الكبرى ذات الجذور التاريخية، يقودنا هو الآخر إلى السؤال المطروح سابقاً والمتعلق بالنقطة التي يجب أن ينطلق منها فعل التأسيس السياسي الثوري للمستقبل في زمن الربيع العربي = (توافق أم تنافس؟) خصوصاً فيما يتعلق بالثنائية المتلازمة سياسياً = (الدولة كفكرة والديمقراطية كآلية سياسية لنظام الحكم) والتي يشكل وجودهما المحايث معنى الدولة الضامنة ببعدها الوطني والمدني، هذا في حال كنا جادين في التعاطي مع سؤال الدولة المدنية الحديثة بعقلية مفتوحة وقادرة في نفس الوقت على قراءة الخصوصية الظرفية التي نعيش في ظلها، لا سيما ووقعنا العربي حتى اليوم يفتقد للكثير من شروطها التي تحدثنا عنها سابقاً في معرض حديثنا عن التجربة الأوروبية، بعد أن تعمدنا تأجيل الحديث بشكل مباشر عن سؤالنا الإشكالي المتعلق في صلب هذه المقالة أو قل وضعنى هذا السؤال بين قوسين لحين الانتهاء من الحديث عن تلك المعطيات التي رافقت فعل التغيير في التجربة الأوروبية وأدت بمجملها وبصيرورتها إلى اختراع فكرة الدولة المدنية الحديثة كنتيجة لمخاض عسير استمر قروناً من الزمن.
فما هو مؤكد في ظل التجربة الأوروبية أن فعل التغيير في هذا المخاض العسير كان واعيا تماما لطبيعة المشكلة وجذرها التاريخي وحتى لِمُشكل التكوين السياسي ولمفهوم الشراكة والتحالفات عند مجمل القوى السياسية والاجتماعية التي انحشرت في معادلة الصراع وفي مسار التغيير الثوري، وحتى عندما لجأت بعض التجارب إلى خيار الحروب الثورية كان فعل التغيير فيها يؤسس لمعادلة صراع سليمة وناجحة تقوم على مفهوم الفكرة الثورية نفسها بين قوى حداثية ومدنية تقدمية تفكر بعقلية المستقبل وبين قوى تقليدية ممانعة تفكر بعقلية الماضي أو أن الماضي هو مبرر وجودها في هذا الحاضر!!!
على مستوى واقعنا العربي قد يكون الحديث عن فكرة إحراق المسافة الزمنية التي استغرقتها الصيرورة التاريخية للدولة المدنية شيئا مقبولا وممكنا لكنه يظل مشروطاً بضرورة التقيد بالخطوات السليمة والعملية في الواقع السياسي والتي تعني عدم القفز على تلك الشروط الموضوعية التي نتوخى منها بناء الدولة المدنية لا سيما في تلك الأقطار التي شهدت أحداث الربيع العربي، بمعنى آخر قد يجوز لنا، وفق هذا المنطق، أن نختصر الزمن الذي استغرق فعل التحول والتغيير في التجربة الأوروبية والمقدر بأكثر من ثلاثة قرون هن عمر التحولات الحرجة التي دارت رحاها بين ثلاث مؤسسات فاعلة ومؤثرة في التجربة الأوروبية، لا سيما وقد ظلت مسألة التراتبية بين تلك المؤسسات في سلم الهرم التنظيمي لشكل السلطة والدولة وكذلك في اتخاذ القرار السياسي المؤثر فيهما وحتى التأثير في حركة الجماعة السياسية وفي بنية المجال السياسي العام مؤشر طبيعي لوجود مفهوم الدولة من عدمها وعلى وجه التحديد الدولة المدنية الحديثة.
هذه المؤسسات الثلاث التي خاضت غمار التحولات الحرجة لمدة ثلاثة قرون، على حد وصف ”رالف إم غولدمان” مؤلف كتاب ”من الحرب إلى سياسة الأحزاب، التحول الحرج إلى السيطرة المدنية” تتمثل أولاً بالمؤسسة العسكرية التي كان يقف على رأسها قبل ثلاثة قرون الرئيس أو الملك، وتتمثل ثانياً بالمؤسسة التشريعية، ثم تتمثل ثالثاً بالمؤسسة الحزبية التي اندفعت موخراً في معادلة التغيير، وقد تموضعت تلك التحولات الحرجة في ظل صراع هذه المؤسسات الثلاث على السلطة والقرار السياسي أو أنها أدت في نهاية المطاف إلى أن تصبح المؤسسة الحزبية بمشروعها السياسي والمدني هي المؤسسة الأولى المؤثرة في القرار السياسي وفي حركة المجال السياسي العام، بل أصبحت هي المؤسسة الحاكمة في الدولة المدنية، بعد أن كانت قبل ثلاثة قرون تقع في المرتبة الثالثة، يومها كانت المؤسسة العسكرية هي الحاكمة وصاحبة القرار في السلطة والدولة، في حين ظلت المؤسسة التشريعية هي المؤسسة رقم اثنين قديماً وحديثاً، تلكم هي مجمل الأفكار التي يدور حولها كتاب صاحبنا ذو العنوان المركب، وهي أفكار ومعطيات تتعلق بصلب موضوع الدولة المدنية وإن أتت في سياقات أخرى.
من نافلة القول إن أحداث الربيع العربي قد كشفت بشكل كبير هشاشة وجود تلك الشروط أو العوامل الموضوعية المتعلقة بصيرورة الدولة المدنية على غرار تلك التي تحايثت وتكاملت بشكل إيجابي في واقع التجربة الأوروبية،
ففي المقام الأول لم تشهد تجربتنا السياسية الدولة بالمفهوم المؤسسي أو الدولة الوطنية كمقدمة سياسية تأتي في سياق التطور لمفهوم الدولة المدينة الحديثة.
وفي المقام الثاني لا وجود لمؤسسة تشريعية فاعلة قادرة على إحداث الفارق في معركة التغيير كما هو حال مجلس النواب الأطول عمراً في اليمن.
وفي المقام الثالث لا وجود لأحزاب سياسية مؤسسية ديمقراطية قادرة على خوض معركة التغيير والتحول على غرار تلك المؤسسة الحزبية التي خاضت غمار التحولات الحرجة نحو المدنية في كل من انجلترا وأمريكا والمكسيك والذي يخبرنا عن دورها رالف في كتابه المذكور سابقاً.
وفي المقام الرابع لا وجود فاعل أو مؤثر لسلطة أهل الفكر في المجتمع العربي على غرار تلك التي يحدثنا عنها المفكر علي امليل في كتابه ”السلطة السياسية والسلطة الثقافية”، فهذه السلطة حتى اليوم غير قادرة على توظيف الجماهير العربية وبشكل إيجابي في معادلة الصراع والتغيير كما فعلت سلطة أهل الفكر في أوروبا.
وفي المقام الخامس لا وجود لنظام معرفي ثقافي عام أو عقل جمعي عربي مشبع بالقيم المدنية = (ثقافة الحرية، ثقافة القبول بالآخر، ثقافة التسامح، ثقافة الحوار)،
وفي المقام السادس ما زالت المؤسسات التقليدية العصبوية حتى اليوم تمارس دورها التاريخي والوظيفي في نفس الوقت ليس على المستوى الأفقي داخل المجتمع العربي من المحيط إلى الخليج = (القبيلة والمذهب والطائفة) بل نجد هذا الحضور السلبي والتقليدي موجودا ومؤثرا وحتى مهيمنا بشكل كبير على المستوى الرأسي داخل بنية السلطة السياسية الحاكمة، كما هو الحال مع ظاهرة القبيلة السياسية في اليمن، على حد وصف الباحث سمير العبدلي في كتابه “ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن”.
وفي المقام السابع ما زالت السياسة كفكرة ومفهوم مدني غير قادرة على تجاوز محنتها أو معضلتها مع الممارسات العربية التي دائما ما تمارس الفعل السياسي مع وجود محرم من الدين أو رقيب من السلطان، أي أن السياسة لم تمارس في مجتمعاتنا العربية كأفكار مدنية مستقلة بذاتها وبمفهومها الدنيوي المدني انطلاقا من مصدرها الطبيعي المجتمعي والإنساني وليس الديني الأيديولوجي المذهبي الذي يربط المنطق السياسي الدنيوي بما هو متعالٍ ومقدس وحتى غيبي، فالفعل السياسي في مجمل الأقطار العربية وفق المفهوم العقلاني الذي يجب أن تكون عليه السياسة كفكرة عامة ما زال غير قادر حتى اليوم على تأسيس مجاله السياسي العام والمفتوح والمتعدد أمام المكونات والقوى الاجتماعية، لأن السياسة كفكرة وكممارسة ما زالت حتى اليوم خاضعة لسيطرة الدين والسلطان.
ناهيك عن المشكلة الكبرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي التي تأتي هنا في المقام الثامن وليس الأخير، لكون هذا الترقيم لا يعني تقديم عامل على آخر بحسب الأهمية أو قوة التأثير في تلك العوامل الموضوعية التي يضاف إليها بالضرورة عامل خارجي يتمثل بقدرة أللا وطني على اختراق السياجات الوطنية التي بنيت في جميع أقطارنا العربية من القش ومن خيوط العنكبوت بتلك الأدوات السياسية السلبية والمتراكمة لهذه الأنظمة العربية الحاكمة منذ عقود بقوة الحديد والنار.
التدخلات اللا وطنية حين تنجح بمد يديها إلى الداخل الوطني دائما ما تبدأ جدول أعمالها بإزاحة المشروعات الوطنية مع اتخاذها سياسات رجعية تعمل على إضعاف أي حامل سياسي لهُ علاقة بفكرة التغيير وحتى بفكرة الثورة أو بالمشروع الوطني والمدني، كما هو الحال مع تدخل دول البترو دولار التي تدخلت بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن غيرها في ثورة الربيع العربي، بحيث استطاعت تلك الدول بفائض المال لديها وبمنطق سياستها الرجعية والانتقامية على تحويل بعض تلك الأقطار التي شهدت فعلاً جماهيراً ثورياً وسلمياً في عام 2011 إلى حمام دم غير قابل للجفاف وإلى حروب عبثية غير قادرة على إنتاج شروط التحولات التاريخية/ الثورية نحو المستقبل، لا سيما وأن تدخلها العسكري وحتى السياسي واللوجستي في اليمن وليبيا وسوريا نجده يتعارض مع منطق ومفهوم الحروب الثورية القادرة على الانتصار لفكرة التغيير والتقدم في مسار الدولة المدنية التي تعنونت بها جميع ثورات الربيع العربى، هذا في حال إن سلمنا جدلاً أن الحرب كانت خياراً مفروضاً لا مناص منه كما هو الحال في اليمن مع تحالف القوى الانقلابية التي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني وانقلبت على دستور الدولة الاتحادية بقوة السلاح والنار وبمنطق المليشيات المنفلتة التي أصبحت، للأسف الشديد، على إثر هذا الانقلاب تؤسس واقع اللا دولة واللا سياسة وأللا وطنية وأللا تعددية سياسية وحزبية في طول البلاد وعرضها وليس في مناطق سيطرة الحركة الحوثية فقط، وهذه اللآت التي تؤسس اليوم في مربعات الشرعية ومربعات القوى الانقلابية على حد سواء تتعارض مع أي اعتمالات سياسية ناجعة تدفع باتجاه مستقبل الدولة المدنية.
الحديث عن تلك المعطيات الواردة في مجمل هذه المقالة بلا شك يجعل الصورة قاتمة بشكل كبير إذا لم تكن تلك الصورة محبطة للكثيرين من القراء، لكن ذلك لا يعني قط أن الثورة في زمن الربيع العربي كانت خطأ أو كانت غير لازمة أو أنها تتحمل مسؤولية ما يجري بقدر ما يعني ذلك أننا اليوم مطالبون بتوسيع زاوية الرؤية النضالية سياسياً ووطنياً (وبشكل يجعلنا قادرين على تجاوز حدود المشروعات الصغيرة أو الهويات الجزئية التي تحاصرنا وتجعلنا ندور في فلكها الممانع لما هو وطني) حتى نتمكن من الإمساك بتلابيب المشكلة السياسية التي أصبحت في بعض الأقطار العربية وعلى إثر أحداث الربيع العربي تعاني من سيولة مكثفة في تشعباتها التي تجاوزت حدود المفهوم السياسي إلى ما هو اجتماعي كما هو الحال في اليمن.
من نافلة القول إن تلك التشعبات في جميع أحوالها تعد نتيجة طبيعية وبأثر رجعي لمسألة غياب الدولة بمفهومها الوطني، والديمقراطية بمفهومها السياسي الليبرالي = (الثنائية المتلازمة في مفهوم الدولة المدنية) التي تحركت الجماهير العربية الثائرة منذ عام 2011 للبحث عنها والمطالبة بها، ومع ذلك ظلت (الدولة المدنية) حتى اليوم سؤالاً إشكالياً مطروحاً على طاولة النضال الوطني في جميع أقطارنا العربية في حين تبدو إشكاليتها مضاعفة إذا ما تم إسقاطها على الواقع العملي بمنطق تلك الشروط الموضوعية التي نفتقد لوجودها حتى اليوم، لكن وجودها يظل هو الحل الذي لا بد منه بد، والذي يجب أن نعمل دون كلل في سبيل الوصول إليه ونناضل دون يأس من أجل اختراعه في حياتنا على اعتبار أن حل المشكلة السياسية لا سيما المتعلقة بالسلطة والحكم يظل هو المدخل السليم والقادر على تقديم الحلول الجذرية للمشكلة العربية التي تبدو متشعبة أكثر من اللازم.
مما لا شك فيه أن مسألة الصراع والاقتتال على السلطة والحكم هي المشكلة الكبرى التي تأتي في مقدمة خصوصيتنا العربية الممانعة على امتداد تجربتنا التاريخية منذ السقيفة وحتى اليوم أو كما قال الشهرستاني ”لم يُسل سيف في الإسلام كما سُل على السلطة والحكم”، وهذا يعني أن الدم الذي سفك داخل الجغرافية العربية من أجل السلطة والحكم في ظل الإسلام أكثر بكثير من الدم الذي سفك في سبيل نشر الرسالة والإسلام نفسه والذي ما زال حتى اليوم يقدم بكل مفارقة عجيبة كأيديولوجية مذهبية أحادية أو كجمله اعتراضية في حقل السياسة تقف بشكل ممانع في وجه الحلول السياسية العملية والعقلانية التي تحقن دماء الناس وتؤدي في نفس الوقت إلى أن تُوضع تلك السيوف المسلولة منذ صفين وحتى اليوم في أغمادها ولا تُسل من جديد في مستقبل الأجيال القادمة بتلك الكثافة والسماجة التي يحدثنا عنها الشهرستاني بكل حسرة وندم، لا سيما وأن الدولة المدنية في جوهرها السياسي إذا ما وجدت سوف تجعل من الوصول إلى السلطة والحكم مسألة سياسية مدنية محكومة بقاعدة سياسية عقلانية ”وليس دينية إيديولوجية” تقوم في الأساس على آلية ديمقراطية تعمل على عد الرؤوس وليس على قطعها.
نستطيع القول إن الفعل الثوري في زمن الربيع استطاع أن يسقط العديد من الحكام المتسلطين والمستبدين منذ عقود، بل واستطاع في بعض تجاربه أن يسقط الأنظمة الحاكمة برمتها كما حدث في ليبيا وتونس، وبغض النظر عن المآلات السلبية أو الإيجابية التي تموضعت في هذا القطر العربي أو ذاك وما زالت حتى اليوم غير مستقرة، فإن الشيء الجامع والمشترك بين تلك الأقطار هو عدم وجود الدولة الوطنية التي تعد مقدمة سياسية وطبيعية في صيرورة الدولة المدنية الحديثة على غرار تلك الدولة الوطنية التي كانت موجودة في بعض دول أوروبا الشرقية إبان الثورة الجماهيرية التي اندلعت في تسعينيات القرن الماضي وعرفت يوم ذاك بالثورة البرتقالية والتي تمكنت من إسقاط الأنظمة المستبدة الحاكمة وشرعت مباشرة في العملية التنافسية الديمقراطية دون أن تستطيع الثورة المضادة أو السلطة العميقة أن تعيق عملية التحول السياسي والديمقراطي نحو الدولة المدنية، بمعنى آخر نستطيع القول إن تلك الأحزاب أو الأنظمة الحاكمة التي أسقطتها الثورة البرتقالية في دول أوروبا الشرقية عملت خلال فترة حكمها بشكل إيجابي على بناء الدولة الوطنية، لذلك استطاعت الثورة البرتقالية بعد سقوط الاستبداد وبكل سلاسة أن تصل ما يجب أن يكون ={الديمقراطية} بما هو كائن ={الدولة الوطنية} وقابل للبناء عليه في مسار التحول والتغيير نحو الدولة المدنية، عكس الأحزاب والأنظمة العربية التي حكمت عقودا من الزمن، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً في بناء الدولة الوطنية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتوقفت عند حدود السلطة التي أصبحت في ظل الجمهوريات العربية المفرغة من محتواها وقيمها تورث في أبناء الرؤساء على غرار ما يجري في نظام الممالك الوراثية دون خجل من فكرة الجمهورية التي أتت على أعقاب ثورات وتضحيات كبيرة!!!
الحديث عن إشكالية الدولة والديمقراطية على مستوى الواقع العربي حديث مرهق ومتشعب بتشعب المشكلة العربية التي تقف اليوم بكل أبعادها في وجه مشروع الدولة المدنية وحتى في وجه القوى المدنية في حال إن وجدت هنا أو هناك دون تأثير كبير في مجريات الأحداث التي تدحرجت سلبياً أكثر منها إيجابياً بقصد فاعل أراد أن يجرم الفكرة الثورية بتداعياتها السلبية التي لا تخلو من الاصطناعية الممولة والممانعة في بعض الأقطار، قبل أن تتحول فكرة الثورة ومشروعها في تلك الأقطار إلى نموذج جذاب وقادر على تجاوز الحدود السياسية إذا ما نجحت الثورة في التعاطي مع فكرة التغيير، ومع هذه التشعبات والتدخلات فإن طبيعة الكتابة في هذه المقالة تفرض علينا أن نعمل على لمّ موضوعها في الكتابة بقدر الإمكان وبشكل يجعل الحديث فيها يقترب من تلك الأسئلة المثارة سابقاً والمتعلقة بإشكالية الدولة والديمقراطية لا سيما وأن أحداث الربيع العربي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما ينقص شعوبنا العربية ليس عدم وجود الديمقراطية الليبرالية فحسب، بل إنها ما زالت حتى اليوم تعيش في ظل هلامية الدولة الوطنية التي يشكل وجودها قابلية سياسية ناجعة لفكرة التحول المدني في مضمار السياسة والديمقراطية، فالسلطة التي نعيش في ظلها ناهيك عن كونها قادرة على إفراغ الديمقراطية من محتواها كما كان يفعل الحكام العرب قبل أحداث الربيع العربي، فإنها تظل في كل الأحوال حالة سياسية نابذة وغير قابلة لفكرة الديمقراطية ولمسألة التعددية السياسية، وحتى لمبدأ المشاركة في السلطة والثروة، على اعتبار أن التوزيع العادل للدخل والثروة يظل هو الشرط الموضعي القادر على منح المواطن البسيط القدرة على الاحتفاظ بحرية الإرادة والاختيار في العملية السياسية الديمقراطية = (كرامة الصوت الانتخابي في العملية الديمقراطية) وبدون هذا التوزيع العادل للدخل والثروة يتحول صوت المواطن الذي يمنح الشرعية للحاكم من إرادة حرة واقتدار سياسي إلى سلعة يتم تبادلها جبراً مقابل المصلحة الشخصية أو رغيف الخبز، وهذا ما يحدث في ظل وجود السلطة في التجربة العربية.
إذاً، إشكالية الدولة الوطنية والديمقراطية الليبرالية تبدأ من نقطة عدم وجودهما في الواقع العربي، وهذا ما يجعل الفعل الثوري في زمن الربيع العربي معنيا بدرجة رئيسية بتحديد نقطة البداية والانطلاق في حال تعاطيه الجدي والمسؤول مع سؤال الدولة المدنية، بمعنى آخر هل نبدأ بالوقوف على مشكلة الدولة الوطنية أم على مشكلة الديمقراطية الليبرالية، وعطفاً على ذلك هل نبدأ بالتوافق الوطني أم بالتنافس السياسي؟
بمنطق هذه الرباعية التي تفرضها خصوصيتنا العربية في زمن الربيع العربي نستطيع القول، على سبيل المثال، إن الفعل الثوري في مصر قفز على خطوة كانت ضرورية في مسار التحول والتغيير حين بدأ بالوقوف على مشكلة الديمقراطية على إثر إزاحة الرئيس حسني مبارك، فقد تم الشروع مباشرة في الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية في ظل وجود السلطة القائمة = (التي عرفت فيما بعد بالدولة العميقة) وهذا التوجه الديمقراطي القائم على التنافس بعد سقوط مبارك أعاق مشروع الدولة المدنية في مصر!!!
فالانتخابات الديمقراطية أدت إلى فوز الرئيس مرسي ثم إلى فوز أغلبية ذات توجه إسلامي في مجلس الشعب المصري أو بمعنى آخر الأحزاب القائمة تاريخياً على الجملة الدينية وعلى الخطاب الإنشائي = (سلفيين + إخوان مسلمين) وإذا كان هذا الفوز شيئا طبيعيا ومقبولا وحقا مشروعا لهؤلاء على اعتبار أن غاية الديمقراطية هي منح الحق في ممارسة السلطة للأغلبية العددية التي أفرزتها صناديق الاقتراع السري، إلا أن تقرير ما يتعلق بمسألة الدولة الوطنية بكل أبعادها لا سيما الدستور بناءً على تلك الأغلبية الحزبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع كان هو الخطأ الفادح والمُشكل الكبير في عهد مرسي، فالدولة في حد ذاتها تعبر عن حالة سياسية وطنية ولا تعبر عن حالة سياسية حزبية، والدستور يظل في كل الأحوال هو الإطار القانوني والمرجعية السياسية للدولة على اعتبار أن الدستور هو عقد اجتماعي يعبر عن إرادة شعب ولو بالحد الأدنى المتفق عليه ولا يعبر عن إرادة الأغلبية الحزبية في الممارسة الديمقراطية، هذا يعني أن الدولة الوطنية بكل أبعادها السياسية والقانونية وحتى فيما يتعلق بهويتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تظل نتاجا لحالة من التوافق الوطني بين المكونات السياسية وليس نتاجا لحالة من التنافسية الديمقراطية الحزبية الذي يفترض أن يأتي كخطوة ثانية بعد أن يتم بالضرورة حسم مسألة الدولة التي تعد من جهة أولى انتصارا للهوية الجامعة على المستوى الوطني، ومن جهة ثانية تعد حالة ضامنة على المستوى السياسي وناجعة في نفس الوقت للممارسة الديمقراطية التنافسية السلمية بين جميع المكونات الحزبية ذات البرامج والمشاريع الوطنية، ومن هذا وذاك يجد المواطن نفسه أمام مفهوم الدولة الضامنة أو الدولة المدنية الحديثة.
في اليمن سارت الخطى بشكل أفضل في مسار فعل التغيير الثوري وأقصد على وجه التحديد ما يتعلق بثنائية الدولة والديمقراطية، فلم يتم القفز مباشرة نحو الديمقراطية التنافسية على إثر إزاحة صالح، كما حدث في مصر بعد إزاحة مبارك، بل تم التركيز أولاً على مسألة بناء الدولة الوطنية التي تم إسقاطها من جدول أعمال الوحدة اليمنية التي تأسست في عام 1990 بين شمال اليمن وجنوبه في ظل حكم الحزب الاشتراكي اليمني في عدن والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء.
قد يقول قائل إنه تم انتخاب عبد ربه منصور هادي أولاً، لكن ذلك في حقيقة الأمر لا يمت بأي صلة لمسألة الديمقراطية التنافسية المقصودة في حديثنا، فما حدث هو مجرد استفتاء على شخص عبد ربه منصور هادي بقصد الحفاظ على ماء وجه صالح قبل رحيله عن رأس السلطة، بمعنى آخر أراد نظام صالح أن يكون هذا الأخير في الخطاب السياسي وفي الأدبيات السياسية المتداولة مستقبلاً هو الرئيس السابق لليمن وليس الرئيس المخلوع على اعتبار أن مصطلح المخلوع له دلالاته في زمن الربيع العربي.
بلا شك وجدت أخطاء متعددة في مسار الفعل الثوري في اليمن وهي بطبيعة الحال قد أدت إلى هذه المآلات التي نعيش في ظلها حتى اليوم، لكن طبيعة المقالة التي نحن بصدد كتابتها لا تستدعي الحديث عن تلك الأخطاء، فما يهمنا في ذلك هو أن الأحزاب السياسية في اليمن، وهذا شيء محسوب لها، أصرت على فكرة الحوار الوطني الشامل التي كانت تطرح من قِبلها قبل أحداث الربيع العربي أثناء اللقاءات البينية بين السلطة والمعارضة، ولم يتم الإستجابة لها، لا سيما في ما يتعلق بانحراف مسار الوحدة وبمسألة الدولة الوطنية بكل أبعادها السياسية والقانونية والدستورية التي تحددت لاحقاً في مؤتمر الحوار الوطني بصورتها الاتحادية، على اعتبار أن خصوصية المشكلة السياسية والواقع الاجتماعي الذي تم تفخيخه في اليمن أكثر من اللازم بفعل السياسات الخاطئة والمتراكمة من قبل نظام صالح، قد استدعت بالضرورة تقديم مثل هذه الحلول السياسية الناجعة والمتعلقة بشكل الدولة كحد أدنى للحفاظ على الوحدة اليمنية وكذلك للحفاظ على الهوية اليمنية الجامعة على المستوى الوطني التي أصبحت في عهد صالح وحلفائه من القوى التقليدية (ثلاثية الأبعاد والتكوين الممانع، قبلية ودينية وعسكرية التي انتصرت بقوة السلاح في حرب 1994م لمفهوم الإقصاء والاستقواء) قد أصبحت قابلة للانشطار والتشظي أكثر من اللازم وبشكل يتجاوز حالة الانقسام السياسي الذي كان قبل عام 1990م يقف عند حدود البرميل المصطنع والذي ظل عقوداً من الزمن يقف كرمزية نكرة على الجغرافية اليمنية وبشكل يدين سياسة الحكام في اليمن ليس إلاّ، لا سيما وأن المواطن اليمني في الشمال وفي الجنوب كان على الدوام يشعر بالانتماء لليمن الواحد وللهوية الوطنية الجامعة، بل ويتطلع سياسياً واجتماعياً إلى يوم الوحدة التي سوف يختفي في ظلها ذلك البرميل الواقف بشكل يتنافى مع أحكام الجغرافية والتاريخ في اليمن، أما اليوم وكنتاج لتلك السياسات السمجة لا سيما تجاه الجنوب والتي مارسها تحالف صالح والقوى التقليدية ثلاثية الأبعاد والتكوين الممانع لمفهوم دولة الوحدة منذ 94م، فقد تسرب الانقسام السياسي وحتى الاجتماعي إلى داخل نفوس اليمنيين وبشكل مخيف أصبح يستدعي ويستقطب بين الحين والآخر كل النماذج والممارسات العبثية التي تم دفنها في الجنوب بعد ثورة أكتوبر والتي كانت تتقاطع بالمطلق مع مفهوم الهوية الوطنية الجامعة لليمنيين التي تظل بقوة المنطق ضاربة في أعماق التاريخ والحضارة منذ القدم في اليمن.
بفعل تلك الممارسات السياسية والاجتماعية التي تتعارض مع مفهوم الوحدة منذ صيف 94 والتي ظل نظام صالح يكابر عليها ولا يعترف بوجودها كمشكلة سياسية واقعية لها من الأبعاد والمآلات الخطيرة على مستقبل الأجيال في اليمن الموحد تشكلت القضية الجنوبية، التي فشل نظام صالح في احتواء اعتمالاتها السياسية التي تحولت إلى قضية عادلة تتعلق بمفهوم الوحدة اليمنية وبمفهوم الدولة الوطنية وبمفهوم الشراكة الوطنية بين الشمال والجنوب، وحتى بمفهوم العملية الديمقراطية التنافسية التي تم إفراغ محتواها حتى يوم اندلاع الفعل الثوري في عام 2011م، الذي استطاع أن يمنح اليمنيين في الشمال وفي الجنوب فرصة تاريخية وحقيقية للوقوف على جوهر المشكلة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي عمل بمنطق التوافق الوطني على إعادة صياغة مفهوم الدولة وفق أدوات وأسس وطنية بدت ناجعة ومؤهلة في الواقع وبشكل يجعل من اليمن دولة قادرة {على عبور المضيق}، على حد وصف أحد عتاولة السياسية في اليمن "دكتور ياسين سعيد نعمان" في كتابه المميز تحت هذا الاسم.
وحتى فيما هو أكثر نجاعة في عملية التحول والتغيير فقد تحايثت عملية الوقوف على مشكلة الدولة الوطنية في اليمن ={صياغة مشروع الدولة الوطنية الاتحادية في مؤتمر الحوار الوطني} مع العمل على تفكيك منظومة السلطة القائمة لا سيما مؤسسة الجيش والأمن التي تم الشروع في هيكلتها بُغية تحويلها إلى مؤسسات وطنية تعمل على حراسة عملية التحول والتغيير في اليمن، لكن تلك الهيكلة المتعلقة بالجيش لم تصل يومها للحد اللازم داخل المؤسسة العسكرية ولم تأخذ الوقت الكافي لها، لا سيما وأن العبرة في هيكلة الجيش بناءً على اُسس وطنية تعد مسألة تتعلق ابتداءً بإعادة صياغة مفهوم العقيدة القتالية والولائية لجميع الأفراد والضباط أكثر من كونها عملية تتعلق بتغيير قادة المعسكرات والألوية، وهذا في حد ذاته يتطلب وقتا كبيرا لا يقاس بسنة أو بسنتين على أقل تقدير، وهو ما لم يتَح أمام فعل التغيير الثوري في اليمن، لا سيما وأن قوى الثورة المضادة كانت تتقارب بخطى متسارعة في أجندتها، بل دخلت مع فعل التغيير داخل المؤسسة العسكرية في سباق مع الزمن وبشكل أدى إلى تمكين تحالف صالح والحوثيين من الانقلاب على مشروع الدولة الوطنية الاتحادية في لحظة فارقة وفي منعطف تاريخي بدت فيه اليمن قادرة على تجاوز معضلة الرسوب المتكررة في اختبارات السياسة.
على إثر هذا الانقلاب الذي أعاق مسار التحول التاريخي، دخلت اليمن في حروب طاحنة أصبحت تتكشف وتفتقد تدريجيا لشروط الحروب الثورية المؤهلة لإنتاج شروط التحولات التاريخية ناهيك عن كونها أسقطت بكل سماجة مبدأ السيادة الوطنية وكشفت بشكل سافر غِطاء الداخل الوطني على مصراعيه أمام أجندات ورغبات ومطامع قوى الخارج اللا وطني إلى أجل غير مسمى.
إذاً، نستطيع القول إن فعل التغيير في اليمن كان موفقاً في خطواته فيما يتعلق بتلك الثنائية المتلازمة في مفهوم الدولة المدنية = {الدولة الوطنية + الديمقراطية الليبرالية} فقد عمل مؤتمر الحوار الوطني بآلية توافقية ولو بحدها الأدنى على تحديد المشكلة اليمنية التي تتمثل بعدم وجود الدولة الوطنية أولاً، لا سيما وإن هذه الأخيرة تعد في كل الأحوال مقدمة سياسية ضرورية وشرطا موضوعيا في صيرورة التحولات المدنية والسياسية وحتى الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمفهوم الواسع للدولة المدنية.
ومع أن مسألة الدولة الوطنية في اليمن ظلت منذ عام 1990م محل اعتراض شديد تارةً بأدوات سياسية وتارةً بأدوات عسكرية من قبل تحالف القوى التقليدية الممانعة = {ثلاثية الأبعاد والتكوين} التي ترى في مفهوم الدولة الوطنية فكرة تتقاطع مع مصالحها السياسية والاقتصادية التي يتم تغليفها في خطاب ديني يستثمر غالباً في رأس المال السياسي، إلاّ أن الدولة الوطنية بشكلها الاتحادي أصبحت هي القضية المركزية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبشكل يُلزم الشُروع في تنفيذها أولاً قبل الدخول في العملية الديمقراطية التنافسية بين المكونات السياسية الحزبية التي تعد هي المؤسسة الحاكمة في الدولة المدنية، ولهذا فإن الانقلاب في اليمن استهدف في المقام الأول مشروع الدولة الوطنية وعلى يد جماعة تحمل فكراً سياسياً يتقاطع بالمطلق مع مفهوم الدولة الوطنية، بل تحمل أيديولوجية ثقافة تعمل على سحب المجتمع إلى عصر ما قبل الدولة الوطنية وذلك عن طريق النفخ في الهويات الجزئية المذهبية والسلالية القادرة في نفس الوقت على استدعاء كل النماذج التاريخية السمجة والقيم الثقافية الماضوية والعصبوية وحتى الدخيلة على المجتمع والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى تعميق حالة من الفرز المقيت واللا معقول داخل المجتمع اليمني وبشكل يعمل على تفتيت مفهوم الهوية الوطنية الجامعة لليمنيين والتي تعد بحد ذاتها شرطاً موضوعياً في مفهوم الدولة الوطنية، كما أن تجاوز تلك القيم الماضوية والنماذج التاريخية التي يتم استدعاؤها وإعادة إنتاجها اليوم في الشمال والجنوب يعد هو الآخر شرطاً موضوعياً في مفهوم الدولة المدنية على اعتبار أن الدولة المدنية تتطلب على مستوى المجال الاجتماعي وحتى السياسي عقلاً جمعياً ومخيالاً سياسياً مشبعاً بالقيم المدنية الحديثة وليس العكس من ذلك!!!
الحديث عما جرى في مصر واليمن ليس سوى أمثلة واقعية على مُشكل التغيير ومعوقاته وحتى عن بعض أخطائه في زمن الربيع العربي، لا سيما فيما يتعلق بتصويب الخطوات السليمة في مسار الدولة المدنية التي تظل بعيدة المنال رغم حجم التضحيات التي تقدم بكثافة وكرم في أي عملية ثورية من قبل الشعوب العربية التي بلا شك "تستطيع أن تدمر ما تريد ولكنها لا تستطيع أن تبني ما تريد"، على حد وصف المفكر الكبير محمد جابر الأنصاري.
صحيح تم اغتيال الفرصة التاريخية في مصر وفي اليمن بدعم إقليمي، لكن الفارق بينهما في تحديد طبيعة المآلات وحتى فيما يتعلق بنضالات القوى الوطنية التي يجب أن تصطف في مواجهة الانقلاب ومآلاته، سوف تُحدده طبيعة الخطوات المتخذة من قبل فعل التغيير في البلدين التي تم الانقلاب عليها ابتداءً، بمعنى آخر إذا كان ما حدث في مصر السيسي هو انقلاب على العملية السياسية الديمقراطية وبشكل أعاد إنتاج نظام الاستبداد السياسي باعتمالاته السياسية وبأدواته القمعية التي كما قلنا يتجاوز فعلهما السمج ما كان موجوداً قبل ثورة 2011م وحتى ما كان موجوداً قبل ثورة 1952م في مصر، لهذا نجد اليوم أن نضالات القوى المعارضة لعبد الفتاح السيسي وحتى خطابها السياسي والإعلامي محشورة في زاوية الكشف عن ممارسة الاستبداد السياسي للنظام الحاكم في مصر دون اكتراث في الحديث عن مشكلة عدم وجود الدولة الوطنية التي مثل غيابها وعدم الوقوف على مشكلتها أولاً -بعد سقوط نظام الرئيس مبارك- سببا جوهريا ومباشرا لقدرة السلطة لا سيما العسكرية في مصر على ابتلاع الديمقراطية التي تظل في هكذا حال بدون حامل سياسي عضوي وموضوعي = {الدولة الوطنية} وهو ما يعني أن الصراع في مصر سوف يستمر بطريقة حلوزنية وغير ناجعة بين القوى السياسية على حكم السلطة وباعتمالات تؤدي إلى إزاحة مفهوم الدولة المدنية حتى إذا تم إسقاط السيسي وصعد الآخرون محله في رأس السلطة ما لم يستطع فعل التغيير الثوري في مصر وفي غيرها من الأقطار العربية تحديد نقطة البداية في حل المشكلة التي تتمثل أولاً بضرورة إنتاج شروط الدولة الوطنية كأرضية متينة وصالحة لممارسة العملية السياسية الديمقراطية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الانتقال السلمي للسلطة في ظل بقاء الدولة كديمومة وكحالة سياسية ضامنة وقابلة لكل ما هو موجود ومتعدد في المجتمع سياسياً واجتماعيا وثقافيا وحتى دينيياً وانسانياً بشرط عدم تعارض مشاريع هذا التنوع القائم على مفهوم الأنا والآخر مع مفهوم الدولة والديمقراطية والهوية الوطنية الجامعة على اعتبار أن هذه الثلاثية تظل في كل الأحوال محددات ضرورية في مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
في اليمن كما هو معلوم تم الانقلاب على مشروع الدولة الوطنية الاتحادية وليس على العملية السياسية الديمقراطية التي كانت عملياً مؤجلة إلى ما بعد بناء الدولة الوطنية، لكن الكارثة أن الانقلاب الذي قاده تحالف صالح والحوثيين في صنعاء كان بمثابة القطرة الفوارة التي أفاضت كأس المُشكل السياسي في اليمن على ما هو اجتماعي وثقافي كان قابلا في الأساس للانفجار والتشظي أكثر من اللازم بفعل أخطاء سياسية متكررة، لا سيما وأن الانقلاب أتى بعد أن كان اليمنيون على إثر ثورتهم الثالثة عاكفين ولأول مرة في تاريخهم المعاصر على نزع فتيل كل الألغام التي تم زراعتها في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي منذ بواكير دولة الوحدة اليمنية في عام 1990م.
هذا يعني أن تحالف القوى الانقلابية عمل على توسيع الخرق في المشكلة اليمنية على الراقع في معركة التغيير المتعلقة بمستقبل الدولة المدنية الحديثة، بمعنى آخر الانقلاب في اليمن لم يعمل على إعادة الاستبداد السياسي كما حدث في مصر، أو أنه عمل على استدعاء النماذج التاريخية الممانعة في الشمال والجنوب فحسب، بل أطلق في نفس الوقت رصاصة الرحمة على ما تبقى من المفهوم السياسي للوحدة اليمنية، وكذلك على الهوية الوطنية الجامعة لليمنيين بمحدداتها الاجتماعية والثقافية وحتى الوجدانية، وبشكل يجعلنا بلا شك نعود القهقري إلى ما قبل سبتمبر في الشمال وأكتوبر في الجنوب، خصوصاً وأن الانقلاب قاد اليمنيين إلى حرب مفتوحة أمام تدخلات إقليمية أصبحت غير مُلْزمة بعد خمس سنوات أن تكون ملكية أكثر من الملك فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة اليمنية وعلى الهوية الوطنية الجامعة وحتى على مشروع الدولة والديمقراطية طالما وأن اليمنيين أو بعضهم أصبحوا مستعدين أن يتحولوا إلى أحجار على رقعة الشطرنج في معادلة صراع إقليمية تتعارض مع ما هو وطني، وآية ذلك أن النماذج التاريخية التي تم استدعاؤها اليوم في الشمال وفي الجنوب، وأصبحت فاعلة في المشهد اليمني بشكل رئيسي لا تعبر بالمطلق عن حاجة وطنية خالصة بقدر ما هي اليوم مجرد تعبير عن فائض القوى لدى دول إقليمية وهو ما يعني خلط الأوراق أمام اليمنيين بالنسبة لمعركتهم الرئيسية المتعلقة بمشروع الدولة الوطنية وبشكل يخدم القوى الانقلابية الرئيسيه = {النموذج التاريخي في صنعاء} التي تؤكد في كل مبادراتها وفي كل مشاوراتها السياسية رغبتها الشديدة في استدراج الشرعية وجر اليمنيين إلى حلول ترقيعية تتعلق بتشكيل حكومة شراكة وطنية أو غيرها في صنعاء ثم يتم بعد ذلك الشروع فى انتخابات ديمقراطية على اعتبار أن سيطرتها على مفاصل السلطة تجعلها قادرة على خلق حالة من التحكمية في مخرجات العملية السياسية الديمقراطية، وهو ما يعني وفق منطق مبادراتها أو رغبتها العمل على دفن مشروع الدولة الوطنية أو حتى الحديث عنها أولاً كمقدمة سياسية ناجعة وضرورية في مسار التحول والتغيير نحو مستقبل الدولة المدنية الضامنة في اليمن ببعدها السياسي والمدني، وهذا هو المنطق الرغائبي للثورة المضادة أو للقوى السياسية الممانعة لمفهوم الدولة المدنية بشكل عام في زمن الربيع العربي..
علينا اليوم أن نعي جذر المشكلة العربية حتى لا يتكرر رسوبنا في اختبارات السياسة.
*رئيس الدائرة السياسية في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بتعز

