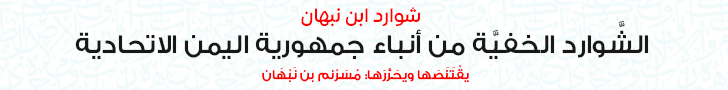ذكرى 11 سبتمبر.. يوم غيّر وجه العالم
العالم - Wednesday 10 September 2025 الساعة 06:47 pm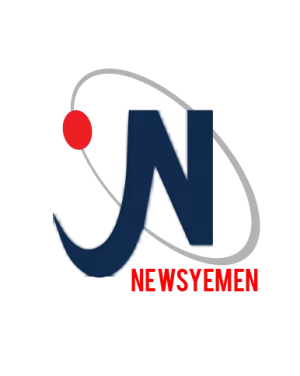 عدن، نيوزيمن، خاص:
عدن، نيوزيمن، خاص:
في صباح يوم الثلاثاء 11 سبتمبر من العام 2001، استيقظ العالم على مشهد لم يعرف له التاريخ الحديث مثيلًا. أربع طائرات مدنية تم اختطافها وتحويلها إلى صواريخ بشرية، لتصطدم اثنتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وتستهدف ثالثة مبنى البنتاجون، بينما سقطت الرابعة في ولاية بنسلفانيا بعد مقاومة الركاب للخاطفين.
لم تكن الحصيلة مجرد أرقام؛ نحو ثلاثة آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين، وصور متلفزة لمبانٍ تنهار في قلب أكبر مدينة أميركية، وغيوم دخان غطت سماء نيويورك. هذه الأحداث لم تهز الولايات المتحدة وحدها، بل صدمت العالم بأسره، وخلّفت جرحًا إنسانيًا عميقًا ما زالت تداعياته حاضرة حتى اليوم.
نقطة تحوّل في النظام الدولي
بعد ساعات قليلة من الهجمات، أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش الابن أن بلاده "في حالة حرب". هكذا وُلد مصطلح "الحرب على الإرهاب"، الذي سرعان ما أصبح العنوان الأبرز للسياسة الدولية في العقدين التاليين.
في أكتوبر 2001، انطلقت الحرب الأميركية في أفغانستان لإسقاط حكم طالبان، الذي اعتُبر الحليف المباشر لتنظيم القاعدة. لكن تلك الحرب لم تتوقف عند حدود كابول، فبعد عامين فقط وجّهت واشنطن أنظارها إلى العراق، متذرعة بامتلاكه أسلحة دمار شامل مرتبطة بالإرهاب، في غزو ما زال حتى اليوم محل جدل عالمي واسع حول شرعيته وتداعياته.
منذ تلك اللحظة، دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة، حيث تحوّل إلى ساحة صراع مفتوح وامتداد مباشر لسياسات ما بعد 11 سبتمبر. لم يكن الداخل الأميركي بعيدًا عن التغيير. فقد أُقر "قانون باتريوت" الذي منح أجهزة الأمن والاستخبارات صلاحيات واسعة في المراقبة والتجسس وملاحقة المشتبه بهم. أنظمة السفر والمطارات تغيّرت كليًا، وأصبحت الإجراءات الأمنية الصارمة جزءًا من الحياة اليومية لملايين البشر حول العالم.
دوليًا، ظهرت تحالفات عسكرية وأمنية متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن، طاردت الجماعات المتطرفة في كل مكان، من جبال أفغانستان إلى صحراء العراق، ومن مدن الصومال إلى صحراء الساحل الإفريقي. لقد أصبح الأمن الدولي في نظر كثيرين مرادفًا للتوسع العسكري الأميركي وحلفائه.
كلفة إنسانية وسياسية باهظة
لكن هذه السياسات لم تخلُ من انتقادات قاسية. تقارير أممية ومنظمات حقوقية ألقت باللوم على "الحرب على الإرهاب"، معتبرة أنها تسببت في مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. العراق وأفغانستان كانتا المثال الأوضح، حيث أدت التدخلات العسكرية إلى تدمير واسع للبنى التحتية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتفشي الفوضى.
وفي مفارقة مأساوية، أسفرت تلك الحروب عن ولادة جماعات أكثر تطرفًا، مثل تنظيم "داعش" الذي استغل فراغ السلطة والفوضى ليتمدّد ويجتاح مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014، مما أعاد العالم إلى دائرة جديدة من العنف والتطرف.
وبعد عشرين عامًا من الهجوم الأولي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس 2021 الانسحاب الكامل من أفغانستان، لينهي أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. لكن المشهد الختامي كان صادمًا: طالبان تعود إلى الحكم في كابول، بينما تترك واشنطن وراءها دولة منهكة، ومجتمعًا مفككًا، وأجيالًا جديدة من المقاتلين.
في الوقت نفسه، شكّلت تلك المرحلة نقطة تحوّل جيوسياسي عالمي. فقد ساهمت في تراجع الهيمنة الأميركية وفتحت الباب أمام صعود قوى جديدة مثل الصين وروسيا، اللتين باتتا تنافسان واشنطن على النفوذ في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
الشرق الأوسط: الضحية الدائمة
داخل الولايات المتحدة، تحوّل يوم 11 سبتمبر إلى ما يشبه "جرحًا وطنيًا مفتوحًا" يعاد استحضاره كل عام. فمع كل ذكرى، تُتلى أسماء الضحايا في موقع البرجين بمشاركة عائلاتهم، وتُقام مراسم دقيقة الصمت في اللحظات التي اصطدمت فيها الطائرات بالمباني. وبالنسبة للأميركيين، لا يمثل هذا اليوم مجرد ذكرى مؤلمة، بل لحظة أعادت تعريف معنى الوطنية والوحدة الداخلية في مواجهة الخطر الخارجي.
كما أن تأثير تلك الهجمات ظل حاضرًا في الخطاب السياسي الأميركي، حيث لا يكاد يخلو خطاب انتخابي أو نقاش حول السياسات الخارجية من استدعاء "تجربة 11 سبتمبر" كمرجع لتبرير المواقف أو توجيه السياسات. وحتى اليوم، يظل السؤال قائمًا داخل المجتمع الأميركي: هل جعلتنا الحرب على الإرهاب أكثر أمنًا فعلًا، أم أنها زادت من المخاطر وخلقت أعداءً جددًا؟
إذا كانت الولايات المتحدة قد عاشت المأساة في يوم واحد، فإن الشرق الأوسط يعيش نتائجها منذ 24 عامًا بشكل يومي. فقد تحولت المنطقة إلى الساحة الرئيسية لتصفية الحسابات الدولية تحت شعار "مكافحة الإرهاب". من أفغانستان إلى العراق، ومن سوريا إلى اليمن، ظل الشرق الأوسط هو الضحية الأكبر، يدفع الثمن من دماء شعوبه واقتصاداته المدمرة ونسيجه الاجتماعي المفكك.
لقد أدت تلك الحروب إلى تفكيك دول كاملة، وولّدت موجات من التطرف والإرهاب أشد خطورة مما كان موجودًا قبل 2001. كما ساهمت في ترسيخ صورة مشوّهة عن العرب والمسلمين في الإعلام الغربي، ما أضعف جسور التعايش بين الشرق والغرب. وحتى اليوم، لا تزال المنطقة تُستخدم كأداة في معادلات القوى الكبرى، تُدار أزماتها من واشنطن وتُنفّذ سياساتها عبر تل أبيب أو غيرها من القوى الإقليمية، بينما يبقى المواطن العربي هو الخاسر الأكبر.
من نيويورك إلى الدوحة
ترى الكاتبة والمحللة السياسية دينا الحسيني أن خطًا مستقيمًا يصل بين صباح 11 سبتمبر 2001 وبين ما يجري في الشرق الأوسط حتى يومنا هذا. فالهجمات التي ضربت قلب نيويورك وواشنطن لم تكن مجرد عملية إرهابية استثنائية، بل كانت نقطة بداية لمرحلة جديدة من الهيمنة الأميركية على المنطقة، حيث أصبح شعار "مكافحة الإرهاب" المبرر الدائم لتدخلات عسكرية متلاحقة امتدت من أفغانستان إلى العراق، ثم تسللت إلى ملفات سوريا واليمن وليبيا.
وتشير الحسيني إلى أن ما بدأ كـ"رد فعل أميركي" تحوّل لاحقًا إلى استراتيجية متكاملة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يتوافق مع مصالح واشنطن وتل أبيب. هذه الاستراتيجية لم تتوقف عند حدود التدخل العسكري المباشر، بل شملت إعادة صياغة التوازنات السياسية، وإضعاف بعض الدول المركزية، وفتح المجال أمام الفوضى كي تكون ذريعة مستمرة للتدخل.
وتضيف أن التاريخ يعيد نفسه، فبعد 24 عامًا بالتمام والكمال، جاء 9 سبتمبر 2025 بضربة إسرائيلية استهدفت قيادات حركة حماس في قلب الدوحة، تحت أعين وبموافقة ضمنية من واشنطن – بحسب تقارير متعددة – لتؤكد أن المسار نفسه ما يزال ممتدًا. فكما استُهدفت كابول وبغداد وصنعاء ودمشق تحت شعار "محاربة الإرهاب"، جاء الدور اليوم على قطر بحجة "ملاحقة قادة حماس". الفارق الوحيد أن الفاعل المباشر هذه المرة هو إسرائيل، بينما الولايات المتحدة تظل المظلة التي تمنح الغطاء وتحدد حدود اللعبة.
وتؤكد الحسيني أن هذا النمط المتكرر يعني أن الشرق الأوسط يظل هو الخاسر الأكبر دائمًا. فمنذ 2001 وحتى اليوم، دفع ملايين الضحايا حياتهم، وانهارت اقتصادات دول بكاملها، وتحوّلت بعض البلدان إلى ساحات حرب مفتوحة. وفي كل مرة، يُعاد إنتاج المبرر نفسه بلغة مختلفة، لكن الهدف النهائي يبقى هو ذاته: تكريس النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة.
وتختم الحسيني بتساؤل جوهري: إلى متى يبقى الشرق الأوسط الضحية الدائمة لسياسات تُرسم في واشنطن وتُنفذ في تل أبيب؟ وهل يمكن للمنطقة أن تكسر هذه الحلقة المفرغة عبر بناء رؤية أمنية وسياسية مستقلة، أم أن النزيف سيستمر تحت الذريعة ذاتها: الحرب على الإرهاب؟
معادلة الأمن والحرية
في الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، يتضح أن العالم لا يزال عالقًا في المعادلة الصعبة التي وُلدت صباح ذلك اليوم: معادلة تقوم على التوازن الهش بين الحاجة إلى الأمن وحماية الأوطان من تهديدات الإرهاب، وبين الحفاظ على الحريات الفردية والجماعية التي تشكل جوهر المجتمعات الديمقراطية.
فالولايات المتحدة ودول غربية عديدة اختارت منح الأولوية للأمن على حساب الحريات، فسنّت تشريعات استثنائية مثل "قانون باتريوت"، ووسّعت صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأقامت منظومات مراقبة غير مسبوقة. ومع أن هذه السياسات وُلدت بدعوى حماية الشعوب من تكرار مأساة مشابهة، إلا أنها أثارت مخاوف واسعة بشأن الخصوصية وحقوق الإنسان، وحتى مستقبل الديمقراطية ذاتها.
لكن ما تغيّر خلال هذه العقود ليس فقط طبيعة التوازن داخل الدول الغربية، بل حجم الكلفة التي تكبّدها الشرق الأوسط تحديدًا. فالمنطقة ظلت المسرح الأساسي لتطبيق تلك السياسات عمليًا: حروب متلاحقة في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، تشريد ملايين اللاجئين، وتدمير واسع للبنى التحتية والاقتصادات الوطنية. كل ذلك جعل شعوب المنطقة تدفع الثمن الأكبر، ليس فقط من أمنها وحريتها، بل من حاضرها ومستقبلها.
وتشير تجارب العقدين الماضيين إلى أن الاقتصار على الحلول الأمنية لم ينجح في القضاء على الإرهاب، بل ساهم أحيانًا في إنتاج موجات جديدة من التطرف. فبدلًا من معالجة الجذور السياسية والاجتماعية للإرهاب، مثل غياب العدالة والتنمية واحتكار السلطة، تم الاكتفاء بالضربات العسكرية التي وسّعت دائرة العنف وأعادت إنتاج أزمات أعمق.
اليوم، وبعد مرور 24 عامًا على الهجمات، تبدو القوى الكبرى مستمرة في إعادة صياغة قواعد اللعبة بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، تاركة الشرق الأوسط في دوامة لا تنتهي من الحروب والمفاوضات غير المكتملة. وهكذا، تبقى معادلة الأمن والحرية مفتوحة بلا حل حقيقي: أمن هش قائم على القوة العسكرية، وحريات مقيّدة في الداخل والخارج، وثمن إنساني باهظ تدفعه المنطقة العربية أكثر من أي مكان آخر.