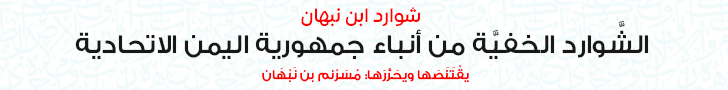اليمن (الأرض) ينقسم إلى جبال وسهول وهضاب وقيعان وصحاري.
واليمن (النّسَب) ينقسم إلى قبائل كبرى وصغرى يجمعها الاعتقاد الموروث بالانتماء إلى جدٍّ مشترك.
أما اليمن بالمفهوم الإداري في العصر الإسلامي، فكان يتراوح بين أن يكون كياناً إدارياً واحداً "ولاية"، أو كيانين أو ثلاثة، وكل كيان ينقسم إلى مخاليف وأقضية متغيرة الحجم والاتساع والعدد.
واليمن (السياسي) كان يتراوح، تاريخياً، بين الدولة الواحدة، أو التجزؤ إلى سلطنات وممالك ودويلات مستقلة ضعيفة متناحرة.
في وقتنا الحالي، ينقسم اليمن الموحَّد، إدارياً، إلى محافظات ومديريات وعُزَلٍ ومدن وقرى.
في بعض فترات التاريخ القديم ظهرت المخاليف، وهي وحدات وأقسام قُطرية واجتماعية في نفس الوقت. وقد يتحول المخلاف أحياناً إلى وحدة إدارية في إطار دولة يكون مركزها في اليمن أو في الخارج.
في القرن الثالث الهجري، أحصى ابن خرداذبة، وهو جغرافي ومؤرخ كان ينشط كما يبدو لخدمة الخلافة العباسية، عدداً كبيراً من المخاليف في اليمن يصل إلى خمسة وسبعين مخلافاً، مستخدماً لفظ "اليمن" في الاشارة إلى الجغرافيا التي يتألف منها اليمن اليوم على وجه التقريب، بدايةً من صنعاء، ومروراً بالجهات كلها وصولاً إلى حضرموت بوصفها مخلافاً من مخاليف "ولاية اليمن".
يقدم ابن خرداذبة تقريراً مفصلاً عن المسافات بين صنعاء -باعتبارها المركز- وبين جميع المخاليف اليمنية بالفرسخ.
في عصور لاحقة، حلت أسماء القبائل والمدن أو القرى محل أسماء المخاليف، باستثناء أعداد قليلة في مناطق متفرقة من اليمن. (إسماعيل الأكوع، مخاليف اليمن، ص65).
وبما أن اليمن ينقسم إلى قبائل، فالقبيلة هنا كلمة ذات معنى مزدوج: وحدة نسبٌ ووحدة أرض.
وقد تحتفظ القبيلة، كرابطة نسب، باسمها الكبير حتى لو ارتحل فريقٌ منها واستوطنوا خارج إقليمها الأصلي، لكن هناك قبائل احتفظت باسمها كرابطة نسب، حتى لو لم يعد لها موطن جغرافي ثابت يجمعها، كالأزد.
وإذا ما انتقلنا إلى التركيبة الجغرافية والتضاريسية لليمن، ففي العصور المتأخرة بات من المعتاد أن نقرأ لدى أكثر من مؤرخ ما يفيد بأن اليمن ينقسم إلى نطاقين جغرافيين: اليمن الأعلى واليمن الأسفل.
إلا أن حدود هذين القسمين على الأرض غير محسومة، وليس هناك إلحاح أو حرص على جعلها محسومة.
وقلّما يهتم الباحثون بالفرق الدقيق بين المدلولين السياسي والجغرافي لهذين الاصطلاحين: اليمن الأعلى واليمن الأسفل.
وعلى الرغم من أن هذا التقسيم يوحي بأن مصدره جغرافي خالص، يستند إلى فارق الارتفاع الطبيعي عن مستوى سطح البحر، إلا أن استعمالاته بعيدة عن أن تكون جغرافية خالصة.
وتستحيل الألفاظ إلى أوعيةٍ مفهوميةٍ اختزاليةٍ مكتظَّة بكمٍّ مهولٍ من الأوهام والأحكام المسبقة والأباطيل.
أحد العيوب الكثيرة لهذا الاختزال أنه يترك لدى المتلقي انطباعاً زائفاً بأن الحدود على الأرض واضحة المعالم بين القسمين.
مثلاً في التقسيم الثنائي "يمن أعلى" و"يمن أسفل"، تغيب عن الأذهان غالباً مناطق شرق ما كان يُسمَّى قبل العام 1990 بـ اليمن الشمالي، مثل مأرب والجوف والبيضاء.
فإلى أي قسمٍ من هذه الثنائية تنتمي هذه المناطق؟ هل إلى اليمن الأعلى أم إلى اليمن الأسفل؟
وتختفي الحديدة وما يرتبط بها من السهل التهامي، تماماً عن الصورة الذهنية التي يوحي بها مصطلح اليمن الأسفل، حيث تشير استعمالاته الحديثة غالباً إلى تعز وإب ضمن ما كان يُسمى بالشطر الشمالي من اليمن.
بينما يُراد من مصطلح اليمن الأعلى، في الاستعمال الحديث، أن يشير حصراً إلى صنعاء وعمران وذمار وصعدة، وبشكلٍ أقل إلى حجة والمحويت.
لكن ماذا عن وصابين وريمة وعتمة، وحجور في حجة مثلاً؟ هل تندرج جغرافياً ضمن اليمن الأعلى؟
وهل جنوب اليمن، وحضرموت وشبوة والمهرة، مناطق تندرج في إطار اليمن الأسفل؟
لا ندري، لأنه ما من قانونٍ موحَّدٍ كي نوزّع على أساسه المناطق بين هذين اليمنين المفترضين!
وهو ما يدل على أن التقسيمات المذكورة ليست بالدقة المزعومة لها.
والحقيقة أن ما تبدو لنا كـ ثنائية جغرافية ليست سوى ثنائية تاريخية، كما يقول عبد الله العروي.
وهذا ما يجب قوله عن الثنائيات الجغرافية اليمنية: الأعلى والأسفل، الشمال والجنوب.
ما نراه نحن هو أن اليمن من حيث تنوع التضاريس أكثر بكثير من مجرد إقليمين: مرتفع ومنخفض.
إنه بالأحرى لوحةٌ فوضويةٌ بمناظر متباينة في الشكل والارتفاع، لوحةٌ تظهر فيها القرى والتجمعات السكانية كالبثور والتقرّحات، متطايرةً هنا وهناك بين المرتفعات المسطحة والجبال الشاهقة والفجوات الترابية والأخاديد الصخرية.
أما المدلول السياسي لكلمتي شمال وجنوب، فليس قديماً كما يظن البعض، بل هو أحدث مما نتخيل.
بوسعنا أن نعثر على بدايات ومراحل ظهور المفهوم السياسي لهذين اللفظين الجغرافيين، ونتعرف على القوى الأجنبية التي ساهمت في رسم حدودهما على الأرض.
بشكلٍ عام، الشمال هو الجزء الذي كان منطقة نفوذ العثمانيين إلى العام 1918م، والجنوب هو منطقة نفوذ الإنجليز إلى العام 1967م.
وعلى أساس هذا التحديد الجغرافي/ السياسي، الذي تم التوقيع عليه من الجانبين العثماني في صنعاء والإنجليزي في عدن أوائل القرن الماضي، بات اليمن مقسوماً إلى مجالين ترابيين بمسارات تطورٍ سياسي واجتماعي متباينةٍ إلى هذه الدرجة أو تلك.
وعلى الرغم من اندماج دولتي الشمال والجنوب عام 1990م في دولةٍ واحدةٍ عاصمتها صنعاء، إلا أن آثار خطّ التقسيم ذاك لم تختفِ من النفوس والأذهان، مثلما طُمست من الخريطة وفي الوثائق والادبيات والخطاب الرسمي لدولة الوحدة.
وقد دأب الوطنيون في القرن الماضي على إشاعة الاعتقاد بأن الخط الفاصل بين الشمال والجنوب خطٌّ استعماريٌّ مصطنع، لا يقوم على حقائق طبيعية جغرافية، ولا على سوابق تاريخية، أو أسس دينية أو مذهبية أو عرقية.
فالجنوب (منطقة النفوذ الإنجليزي)، من الناحية الدينية لم يضم كل شوافع اليمن، بل جزءاً منهم، ومن الناحية الجغرافية لم يضم كل "اليمن الأسفل" أو كل يمن السهول والمنخفضات، بل جزءاً منه.
وسكان الجنوب من الناحية الإثنوغرافية، يتوزعون إلى أنساب قحطانيةٍ حميريةٍ ومذحجيةٍ وهمدانية، وأنسابٍ عدنانية، إضافةً إلى خليطٍ آخر من أصولٍ غير عربية.
لكن حتى كلمة "يمن" نفسها، قبل حلول العصر الحديث، لم يكن لها مدلول سياسي قانوني محدد، بمعنى لم تكن اسماً لدولة.
كانت الكلمة تدل فقط إما على إقليم جغرافي (إقليم اليمن) أو على انتماء نسَبي (الأرومة القحطانية اليمانية) أو على وحدة إدارية (ولاية اليمن) ضمن هذه الامبراطورية الاسلامية أو تلك.
والدول والممالك والسلطنات المحلية التي ظهرت في النطاق الجغرافي اليمني كانت تتسمى حصراً باسم السلالة الحاكمة أو باسم القبيلة المهيمنة في التاريخ القديم.
من جانبٍ آخر، لو ألقينا نظرةً على خريطة الجمهورية اليمنية، سنُدهَش بأن وسط اليمن، أو اليمن الأوسط الموجود في أذهان الناس، ليس هو الأوسط على الخريطة، ولا هو الأوسط في الواقع الجغرافي.
وربما يرجع اعتبار تعز وإب مناطق وسطى إلى توسطهما بين مركزي شطري اليمن قبل العام 1990، في المنتصف تقريباً من المسافة بين صنعاء وعدن.
لكن حتى بهذا المعنى، ليس من المؤكد أن المسافة بين تعز وصنعاء هي نفس المسافة بين تعز وعدن، ومع ذلك يمكن التنازل عن الدقة هنا ولن نخسر الكثير.
أما بعد قيام الوحدة بين شطري اليمن، فقد انتقل وسط اليمن، على الخريطة، إلى موقعٍ آخر بعيداً عن إب وتعز، لكنه بقي في الأذهان لا يشير إلا إليهما.
فلماذا استمرّ الاصطلاح قيد الاستعمال بمحتواه السابق على الوحدة اليمنية؟
ألا يؤكد هذا أن كثيراً من التسميات والاصطلاحات الموروثة هي ضربٌ من الاعتياد المحض؟
اعتيادٌ لا يشترط أن تكون الكلمة فيه مطابقةً للحقائق وللوقائع الحسية.
إن شيوع واستمرار أخطاءٍ من هذا القبيل يعود إما إلى الكسل عن إلقاء نظرةٍ على الخريطة، أو إلى الافتقار إلى الوعي بتاريخية المفاهيم والاصطلاحات، أي الوعي بكونها حادثة مستجدة وليست قديمة أزلية.
أحياناً يكون السبب في استمرار بعض المفاهيم والاصطلاحات، أيديولوجي وسياسي، كما هو الحال مع مصطلحي "الشرق" و"الغرب" بمدلولهما الحضاري والثقافي الذي ساد خلال الحقبة الاستعمارية وما بعدها.
علاوة على ما سبق، يظل الحد المعياري للرقعة الجغرافية التي يغطيها مصطلح "يمن"، أحد المواضيع الإشكالية التي يندر الاتفاق حولها بين المؤرخين والجغرافيين.
فأين يبدأ اليمن بالضبط وأين ينتهي؟
وما هو مبدأ التحديد؟
أهو جغرافي طبيعي، أم سياسي تاريخي، أم سيسيولوجي، أم ثقافي حضاري، أم مناخي بيئي؟
سيقال إن علينا العودة إلى جغرافية أول كيان سياسي موحد في تاريخ اليمن، يمن كرب إل وتر في القرن السابع قبل الميلاد، والتعامل معها كحد معياري لما نعنيه بكلمة "يمن".
حسناً.. لكن هل بوسعنا، من خلال النقوش، رسم خريطة واضحة لتلك الدولة بوصفها السابقة التاريخية المؤسسة للمجال اليمني؟
لا ندري.
المؤكد أن كل موقع، وكل صقع، في النطاق الجغرافي الذي يتفق الأغلبية على تسميته بـ "اليمن" يتمتع في كتب التاريخ بحقوق متساوية مع المواقع الأخرى في حيازة الاسم والانتساب إليه وتمثيله وكأنه شيء يخصه دون أن ينكر على بقية الاجزاء حقوقها فيه.
ليس هناك موقع أكثر "يمنية" من غيره.
وهذا مصدر لبس دائم في الأدبيات التاريخية، ويؤثر على فهمنا وتصورنا لليمن.
مثلاً تجد مؤرخ ينسب أمراً من الأمور إلى اليمن ككل، رغم أن تأثير هذا الأمر وحضوره كان يقتصر فقط على جزء من اليمن.
يفعل ذلك من دون تخصيص لموضع، بل يتحدث وكأن ذلك الأمر كان يشمل كل اليمن.
فمن يحصل على حظ من السلطة والحكم في رقعة من اليمن، بالتزامن مع حكام وسلاطين آخرين موزعين على باقي الجغرافيا اليمنية، تقول عنه كتب التاريخ بأنه "حكم اليمن"، بينما يكون المعنى الحقيقي أنه "حكم في اليمن".
يمكن أن تخبرك الموسوعات التاريخية أن الدولة الزيادية "حكمت اليمن" قرنين من الزمان، وعند التدقيق تكتشف أنها لم تحكم بشكل فعلي سوى أجزاء من اليمن، تتسع حيناً وتضيق حيناً آخر.
وتخبرك الموسوعات الشيء نفسه عن الأئمة الزيديين أو عن الرسوليين والطاهريين وغيرهم، ثم تكتشف الشيء نفسه عند التدقيق التاريخي.
فهؤلاء "حكموا في اليمن" أكثر مما "حكموا اليمن". أو أنهم "حكموا اليمن" قليلاً من الوقت فقط، لكنهم "حكموا بعض اليمن" خلال معظم فترتهم التاريخية.
وتجد مؤرخين يتحدثون عن المدد الزمنية والفترات التي عُمِّرتْ فيها الممالك اليمنية وكأنها قطع متصلة ومتجانسة على صعيد الزمن والنطاق الجغرافي.
وكثيراً ما نقرأ أن الدولة الحميرية حكمت اليمن 600 عام، ولا ننتبه إلى أن هذه المدة تشير فقط إلى الزمن الذي يفصل بين ظهور دولة الحميريين الأول وبين أفولها الأخير.
أي أنها لا تعني انتظام حكم حمير على كل الجغرافيا اليمنية، بنطاقها المعروف اليوم، مدة 600 عام متواصلة.
ونجد في تاريخ اليمن دول (سلالات حاكمة) اتصلت زمنياً لقرنين أو ثلاثة (كالدولة الزيادية أو الرسولية في العصر الإسلامي)، لكن دون اتصال المكان، فنطاقها الجغرافي بين اتساع وانقباض دائمين، وفترات الانقباض تزيد على فترات الاتساع.
وهكذا، فإن الحديث عن اليمن، كأرض وتاريخ، لا يمكن أن يُختزل في خريطةٍ أو حقبةٍ بعينها.
فهو كيانٌ متحوّل الحدود والدلالات، يتّسع ويضيق تبعاً للزمن والسلطة والخيال الجمعي، أكثر مما يتبع خطوط الطول والعرض.
إنه معنى قبل أن يكون مكاناً، وذاكرة قبل أن يكون دولة.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك