ريمة المنسية.. جارة السماء، وبستان الملائكة "الجزء الرابع"
السياسية - Saturday 25 May 2024 الساعة 06:16 pm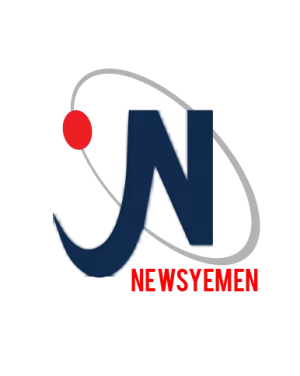 نيوزيمن، زين العابدين الضبيبي:
نيوزيمن، زين العابدين الضبيبي:
بالعودة إلى عنوان المقال قد يعتقد البعض أن الخيال أخَذ الحيز الأوسع في الكتابة عن هذه الجنة المنسية، غير أن الحقيقة هي أكبر بكثير من كل المعاني والأوصاف. وفي الحلقات السابقة ارتَكز حديثنا عن جمال ريمة -تلك الجنة المنسية- بما تزخر به من مقومات طبيعية فريدة، تجعلها وجهةً وغايةً لا بد منها لمن يبحث عن الجمال والنقاهة وبكارة الاكتشاف، وهو حديثٌ يشبه إلى حدٍّ بعيد ما يمكن تسميته بـ"التقريب بين العاشق والوردة"، غير أننا لا بد أن نتساءل أيضًا: من أين لنا بالعاشق الذي يتوق إلى الورد؟! وهو -بالتأكيد- سؤال معقد يدعونا إلى الخوض في جملة من الصعوبات التي تواجه العاشق، وما أكثرها.
ولعل مِن أهمها: افتقار هذه المحافظة الساحرة إلى أهم وأبسط الخدمات الحيوية؛ بَدْءًا من بنية تحتية مؤهلة، كمتنزهات عامة، ومطاعم، وفنادق وغيرها، والأهم من ذلك كله الطريق الذي يحول بين هذا العاشق وبين اكتشاف جنة ريمة والحج إليها كقِبلةٍ سياحيةٍ نادرةٍ وفريدةٍ تتآخى فيها الفصول والمواسم، ويجتمع فيها كل الذي يريده الإنسان ويبحث عنه لينعم بالاسترخاء والهدوء والهواء النقي.
هذه الخدمات التي من المُفترض أنها قد توفرت منذ زمن بعيد لن تجد لها أثرًا في ريمة وأخواتها، مثل مَحميَّتَي "بُرع، وعتمة" القريبتين منها في المسافة والتنوع الجمالي والبيئي الفطري الذي فقدته أغلب مناطق اليمن، في ظل زحف العمران المخيف والمحزن. زحف عمراني دمَّر في طريقه الكثير من خيرات الأرض اليمنية الغنية بالحياة الطبيعية الخصبة، التي كانت تسمى قديمًا "العربية السعيدة".
الحديث عن الخدمات العامة في ريمة لا يقتصر على القرى البعيدة أو التي يصعب توفير تلك الخدمات فيها، فريمة كلها خارج دائرة الاهتمام الرسمي، سواء عاصمة المحافظة "الجبين" أو بقية مراكز مديرياتها الست، ناهيك عن مراكز التجمع السكاني الكثيف في القرى المتناثرة هنا وهناك. هذا الحرمان الخدمي -الذي يبدو متعمدًا- قد أسهم في نزوح الكثير من السكان وتوزعهم في أرجاء الوطن ومنافي الاغتراب للبحث عن الحياة الكريمة ولقمة العيش، ما تسبب في إهدار الأرض وتحولها من حقول إنتاج إلى مراعٍ متخمة بالحياة لا يستفيد منها أحد، رغم أنها لا تحتاج إلا إلى القليل من الجهد لإعادة إنعاشها!
لقد أصبح الحديث عن الزراعة في ريمة مبعثًا للوجع والأسف، لا سيما إذا ما أدرك المرء أن ريمة، بكامل مساحتها الجغرافية، تكاد أن تكون مزرعة واحدة متنوعة التضاريس، متعددة الإنتاج؛ إذ كل منطقة فيها تتميز بزراعة نوع معين من الفواكه والحبوب، وهناك روايات تقول إنها كانت المُصدِّرَ الأول للبن عبر ميناء المخا، والرافد المهم لليمن بأكملها، يقصدها من تضيق بهم الأرض، حتى صار يُضرب بها المثل لمن فقد الحيلة وعزت به الوسيلة فيقال له: "حِجنة وريمة"، وهو ما يشير إلى أنه سيجد فيها ما يتمناه، باعتبارها أرضًا ثريةً وخصبةً وكريمةً يسهل على الإنسان أن يجد فيها الرزق والزاد الذي عز وجوده في سواها.
وكما حرمتنا العولمة من الحياة البسيطة، فقد ألقت بظلالها الكئيبة على الأرض والإنسان، وشغلته عن جنته التي عاش يأكل من خيرها، بمتطلبات الحياة المدنية التي لا تنتهي وبدأت تسرق الكثير من سكانها وتخمد شغفهم بالزراعة واستصلاح الأرض، رغم أنها كريمة معطاءة، تأبى أن تستسلم لعوامل الزمن والإهمال ولا تزال تنتج رغم ذلك الكثير من الفواكه والحبوب، وما يزال البعض من أهلها يأكلون مما يزرعون، ويتشبثون بها كما يتشبث الأطفال بأمهاتهم، أملًا في تحرّكٍ قادمٍ، ولَفتةٍ من الجهات المعنية التي يُتوقع منها أن تستغل هذه المساحة الغنية والمتنوعة، وأن تستثمر فيها وتمد يد العون لأهلها وتشجعهم على استصلاحها لما فيه الخير والفائدة لهم، ولما ستعود به من نفع على البلاد بشكل عام، من خلال توفير الخدمات والاستفادة من السياحة الداخلية والخارجية التي تعتمد عليها أغلب البلدان في دخلها القومي، بما فيها بلدانٌ عربية فقيرةٌ قياسًا باليمن عمومًا، وريمة خصوصًا، التي تتمتع بثراءٍ خصب ونادرٍ، لو أنه وَجَد الاستغلال الأمثل لَتَحَوَّل إلى وجهة سياحية يقصدها كل المشغوفين بالحياة الطبيعية والباحثين عن السكون والهاربين من صخب العالم من داخل وخارج اليمن.
تلك هي ريمة، الكنز المدفون، الذي يترقب هطول يدٍ حانيةٍ بمقدورها أن تكشف جواهرَه النادرة والفريدة، وربما قد يطول الانتظار، رغم أنه قد طال بما فيه الكفاية، غير أن اليأس هو المخلوق الوحيد المطرود من هذه الجنة التي يتفتق الأمل فيها، وينبت على جنبات طرقاتها الوعرة كما تنبت الأشجار.
غير أن استمرار الوضع كما هو الآن لا يبشر بخير على الإطلاق، فريمة مزرعة اليمن المهجورة التي حُرمت البلاد من جُل خيراتها؛ بسبب الإهمال وتحول جزء كبير منها مع مرور الزمن إلى أرضٍ طاردةٍ، ينزحُ منها بعض سكانها نحو عواصم الاغتراب والمدن، بحثًا عن الحياة السهلة، بعد أن نال منهم الكسل وحيّدهم الإهمال عن مواصلة السير في طريق الأجداد الذين شيدوا المدرجات وبنو السدود و"البرك" لري مزروعاتهم وحقولهم التي كانت من أهم الروافد المغذية لليمن ككل عبر التاريخ، في مرحلة لم تكن فيها الحياة متاحة بسهولة، كما هي الآن.
ولا شك أن هذا النزوح السكاني الذي بات يستهوي الكثير من أهالي ريمة وغيرهم، ويدفعهم إلى التخلي عن فلاحة الأرض وزراعتها، قد ترك وسيترك أثره على السوق المحلية إلى أن نجد أنفسنا في قادم الأيام نستورد ما نأكله من أصغر الأشياء إلى أكبرها، إذا ما بقي الحال على ما هو عليه اليوم، وهو ما ينذر بكارثة بدأت أعراضها بالظهور على السطح من خلال ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الزراعية المحلية، نتيجة لانحسار مساحة زراعتها كالطماطم بعد أن كانت تباع بأقل الأثمان في الأمس القريب.
إضافة إلى الازدحام السكاني في عواصم المدن، التي تتوسع على حساب الأرياف العامرة بالحياة الطبيعية والخيرات، بعد أن هجرها سكانها وتوجهوا إلى عواصم المحافظات، التي تخلو فيها الحياة من المشقة التي يكابدها سكان الأرياف في ريمة وأخواتها من بساتين البلاد وحقولها الخصبة.
غير أن هذه الراحة التي توفرها المدن لن تدوم طويلًا؛ إذ سرعان ما سيغدو توفير الخدمات فيها بما يلبي حاجة الناس أشبه بالمستحيل على الدولة والمواطن، وهو ما سيجعل العيش في المدن باهظ التكلفة، لا يقدر عليه إلا من يمتلكون الوفرة التي تساعدهم على توفير احتياجاتهم الضرورية بعد أن جفت الأرض الخصبة، ونال الإهمال وعوامل الزمن من حالتها السابقة، وهو ما يجعل أمر استصلاحها وعودتها لسابق عهدها محتاجًا لعمر جديد وإرادة صلبة لم يعد يملكها سكان المدن الذين تمرغوا في الرفاهية وتنكروا للأرض التي أطعمتهم وعاش على خيراتها الآباء والأجداد من قبلهم.
ولكم أن تتخيلوا حجم الكارثة التي تنتظر الجميع، ما لم يتكاتف الكل للمحافظة على حياة الأرض والاعتماد عليها في توفير ما يحتاجه الإنسان، وما لم تكثف الجهود لإنعاشها حتى تعود إلى إنتاج ما بمقدورها أن تنتجه وتغرق به السوق المحلية والعربية، بما لا يجعلنا أمة فاقدة الحيلة والعزيمة، تعيش على ما يأتيها من خارجها.
وكلي ثقة أن هذه الهواجس ستتلاشى أمام إرادة أهالي ريمة واليمن الأوفياء لأرضهم، وبأنهم لن يستبدلوا جنتهم الحية بسواها، فمن نبتت سواعده ونما عوده من خير الأرض لن يكون لها يومًا الابن العاق، وهذا ما تقوله ريمة وما يسطره رجالها الذين قهروا المستحيل في زمن الحرب فشقوا الطريق وأوصلوها إلى الكثير من القرى، وهو ما لم تفعله الدولة وعجزت عنه طوال ما يقارب الستين عامًا من عمر الثورة وتعاقب الحكومات. ومن يشق الطريق في الصخر الصلد بمقدوره أن يصنع المعجزات، وأن يعيد للأرض الحياة، وهو ما سأشير إليه في الجزء الأخير من هذه الكتابة، بعد أن أخذتنا الهموم عن الاستمرار في محاولة نقل صورة تقريبية بالكلمات لعبقرية الأرض والإنسان في هذه الجنة المسكونة بالجمال والأحلام والواعدة بالثمر والموعودة بالثراء.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك

